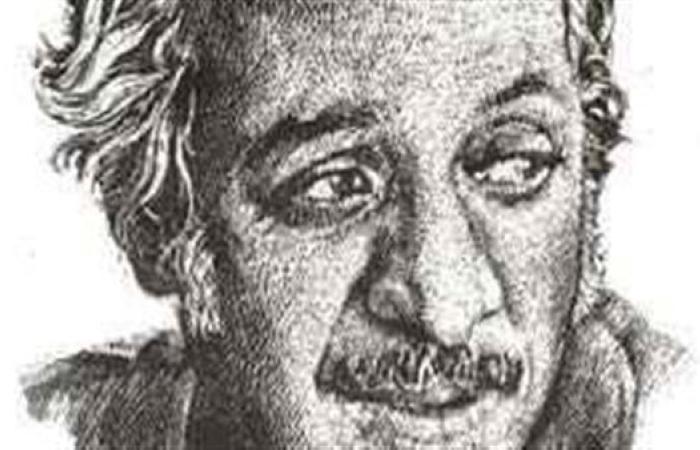«أمي ما ماتت جوعًا.. أمي عاشت جوعانة ولذا مرضتْ صبحاً.. عجزتْ ظهراً.. ماتتْ قبل الليل»
من "مأساة الحلاج"
هذه محاولة لإلقاء الضوء على صلاح عبد الصبور كواحد من شخصيات مصر الخالدة الذين استطاعوا أن يحدثوا بصمة في تاريخ الحياة الثقافية والأدبية.. ليس في مصر فقط بل وفي العالم العربي كله، ويعتبر واحدًا من أعمدة الشعر الحديث في العالم العربي، وترك بصمة لا تُمحى في الأدب العربي عبر إبداعاته المتنوعة التي تميزت بالعمق والابتكار.
شاعرنا الكبير من مواليد مدينة الزقازيق عام 1931، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1947 حيث درس اللغة العربية وآدابها، وتتلمذ فيها على يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى جماعة "الأمناء" التي كوّنها، ثم إلى الجمعية الأدبية التي واصلت مهام جماعة "الأمناء". وكان للجماعتين تأثير كبير على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر. وكان لذلك كله أثره في تكوينه الأدبي والفكري، مما جعله صاحب رؤية ثقافية وفكرية تُعبر عن قضايا الإنسان والمجتمع في سياقاته المختلفة.
بدأ ينشر أشعاره في الصحف وذاعت شهرته بعد نشره قصيدته "شنق زهران" عن حادث دنشواى، وبعد صدور ديوانه الأول "الناس في بلادي" الذى كان بمثابة شهادة اعتماده بين رواد الشعر الحر مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وسرعان ما وظف صلاح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجديد في المسرح فأعاد الروح وبقوة للمسرح الشعري الذي خبا وهجه في العالم العربي منذ وفاة أحمد شوقي عام 1932 وتميز مشروعه المسرحي بنبرة سياسية ناقدة لكنها لم تسقط في الانحيازات والانتماءات الحزبية.
وعندما يُذكر صلاح عبد الصبور، يتبادر إلى الذهن فوراً عمله الرائع "مأساة الحلاج".. قبل أن نغوص فى عالم شاعرنا الكبير، نتوقف مع هذا المقطع من هذا العمل الخالد:
«هل تدري يا شيخي الطيب أني يوماً ما، كنت أحب الكلمات، لما كنت صغيراً وبريئاً، كانت لي أم طيبة ترعاني وترى نور الكون بعيني، وتراني أحلى أترابي، أذكى أخداني، فلقد كنت أحب الحكمة أقضي صبحي في دور العلم أو بين دكاكين الوراقين، وأعود لأفاجئها بالألفاظ البراقة كالفخار المدهون».
«كانت أمي خادمة تجمع كسرات الخبز وفضل الثوب من بعض بيوت التجار، وأنا طفل لا همة لي إلا في هذا اللغو المأفون، مرضت أمي، قعدت، عجزت، ماتت، هل ماتت جوعاً؟، لا، هذا تبسيط ساذج يلتذ به الشعراء الحمقى والوعاظ الأوغاد ليخفوا بمبالغة ممقوتة وجه الصدق القاسي، أمي ما ماتت جوعاً، أمي عاشت جوعانة، ولذا مرضتْ صبحاً، عجزتْ ظهراً، ماتتْ قبل الليل».
تتلمذ على يد أمين الخولى وكان صاحب رؤية ثقافية وفكرية تُعبر عن قضايا الإنسان والمجتمع
كان هذا المقطع من كلمات السجين الثاني في سجن الحلاج، حينما سأله عن الكلمات ليرد هذا السجين الذي لم نعرف ملامحه، لكنها حفرت بالكلمات جسداً نحيلاً، تكاد عظامه تخرج من خلف الجلد المتهدل، عيون لا ينفض عنها بريقها بفعل الدمع المحبوس، ليقول له: «أقوال طيبة، لكن لا تصنع شيئاً.. أقوال تحفر نفسي، توقظ تذكارات شبابي..» لتبدأ ماساة السجين.
كل طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية يحفظون هذا المقطع عن ظهر قلب. ولم لا؟ فهو الأشهر لضمان المرور من اختبارات المعهد، وفي الكثير من الأحيان تحفظه الفتيات أيضًا.. تلك هي العبقرية التي استطاع أن يتركها لنا صلاح عبد الصبور، في مسرحياته الشعرية، والتي كان يصنع من خلالها عودة كبيرة للمسرح الشعري بعد أحمد شوقي ومن قبلهم "هوميروس" صاحب الإلياذة والأوديسة.. تلك اللغة الشعرية التي اختارها عبد الصبور لتكون نقطة تحول في المسرح فلا عجب في أن نجد نصوصه تتجسد على خشبة المسرح من وقت لآخر من النجوم للهواة للدراسات النقدية والبحثية التي تقدر بالعشرات .
صاحب مدرسة شعرية متفردة
استطاع عبد الصبور أن يصنع توجهًا جديدًا في المسرح الشعري، وإذا كان الله أمد في عمره لربما استطعنا أن تكون لدينا هوية مسرحية عربية متفردة في المسرح الشعري القابل للعرض المسرحي، فكانت شخوصه تنبض بالحياة تكاد تخترق الورق والأحبار لتتجسد أمام القارى بل تكاد ترى المشهد المسرحي كاملاً. وجاءت أعماله المسرحية في خمسة نصوص هى "مأساة الحلاج"، "مسافر ليل"، "الأميرة تنتظر"، "ليلى والمجنون"، و"بعد أن يموت الملك".. وقد أفرد النقاد لتلك النصوص عشرات الدراسات البحثية التي تناولتها من مختلف التوجهات منهم من رأى صورة المثقف، ومنهم من رأى أنها تتحدى السلطة، ومنهم من تعامل معها بتوجه الرمزية والدلالة، وبنية النص وبنية العروض المسرحية، والأشكال التي قدمت بها تلك الأعمال.
ثراء فكري ونقدي صاحب أعماله لأنها بالحق تستحق كل هذا التناول ويظل عبد الصبور مادة بحثية ثرية لكل من يريد أن يتناول المسرح الشعري أو تجربته المسرحية، أو حتى كشاعر متفرد له مفرداته وأدواته التي ينفرد بها عن غيره من الأدباء او الشعراء أو كتاب المسرح.
مأساة الحلاج
«مأساة الحلاج» تعبير عن هموم الإنسان المعاصر من خلال استخدام الرمزية والإيحاءات الدينية والفلسفية
ومن خلال تحليل أعمال صلاح عبد الصبور، نجد أنه لم يكن يكتفي بتقديم نصوص أدبية خالصة، وإنما كان يسعى لتوظيف الأدب كوسيلة للتعبير عن هموم الإنسان المعاصر، فنجده في "مأساة الحلاج"، يُظهر هذا بوضوح من خلال شخصية البطل الذي يعاني من صراع داخلي بين ما يريده المجتمع وما يطمح إليه كفرد حر، وبين ما تريده السلطة، فقد استخدام الرمزية والإيحاءات الدينية والفلسفية بما يعكس قدرته على استيعاب التراث الثقافي العربي وإعادة صياغته بطريقة تتفاعل مع القضايا الحديثة، وكان الكثير من النقاد يرون في شخصية الحلاج ملامح من شخصية عبد الصبور نفسه، ولكني أرى في كلمات السجين الثاني كلمات أكثر تعبيرًا عنه هو، حينما لم تستطع الكلمات البراقة في أن تسد جوع أمه، وهنا يقصد بـ"الأم" الوطن، الذي يعاني ويدفع ثمن العلم ويفرح بالكلمات الرنانة وهو في الوقت نفسه يتضور جوعًا ويعاني من أزمات اقتصادية كبيرة. وقد يشوب هذا التأويل الصواب أو الخطأ ولكن هذا هو سحر نصوص "عبد الصبور" احتمالية التأويل واستخدامه للرمزية والدلالة ما يعطي الباحث أو الدارس أو القارئ التأويل التي يتواقف مع همومه ومشاكله ولهذا خُلدت تلك الأعمال في الوجدان الشخصي والجمعي أيضًا.
ويمكن أن يكون أكبر دليل على تلك الرؤية فى رد الحلاج على الشبلي حينما سأله قائلاً : ماذا تعنى بالشر؟
الحلاج: »فقر الفقراء
جوع الجوعي، في أعينهم تتوهج ألفاظ لا أوقن معناها
أحياناً أقرأ فيها
ها أنت تراني
لكن تخشى أن تبصرني
لعن الديان نفاقك
أحياناً أقرأ فيها
في عينك يذوى إشفاق، تخشى أن
يفضح زهوك
ليسامحك الرحمن
قد تدمع عيني عندئذ، قد أتألم
أما ما يملأ قلبي خوفا، يضني روحي فزعاً وندامة»
الفقر والجوع و"مسافر ليل"
كان الفقر والجوع والظلم شرًا من وجهة نظر الحلاج، ولهذا نعيد نشر ما كتبه عبد الصبور حتى يتاح للقارئ التأمل في بعض بيوت أشعاره.. هذا الفقر وهذا الظلم الذي قد يقتل معه الأحلام مثلما كان يفعل عشري السلطة في مسافر ليل أو "بائع التذاكر" والسطور التي كان يمارسها على "المسافر".
يقول عبد الصبور في مسافر ليل: » أنا المسافر في قطار الليل.. لا أحد يعرفني، ولا أنا أعرف أحدًا.. صرت بلا وطنٍ، وبلا أهلٍ، وبلا رغبةٍ في شيء.. كل ما أرجوه أن أصل دون أن يوقظني أحد، أن أغفو وأحلم، أو لا أحلم.. أن أمرّ كما يمر الحلم في نوم المُتعبين».. وهكذا، فجأة نحن أمام إنسان وكأنه ولد لتوه، بل وكأنه يتحسس خطواته الأولى في الحياة وهذا القطار السائر بلا هوادة هو قطار الحياة التي يسير دون أن يفكر ولو للحظة أن يتوقف، لأن بتوقفه ستتوقف معه الحياة.
يقول المسافر: أنا إنسان \ سفري ليس جريمة \ وصمتي ليس خيانة\ وصبري ليس خوفًا.
ومن كلام المفتش (رمز السلطة):
" هأنذا جئتكم...
بالنيابة عن القوة، عن الأمر، عن العرف، عن صوت السوط،
أنا القانون،
أنا الأمر النافذ، أنا المُطلق
أنا مَن لا يُسأل، ولا يُجادل، ولا يُطاع سواي...
وأيضًا يقول
" أنا لا أعرف من أين أتى هذا الليل،
ولا كيف امتدت سكته بين الوجوه،
ولا لماذا صمت الراكبون
كأنهم موتى في مقصورة مسافرة".
إضافة إلى "مأساة الجلاح" و"مسافر ليل"، كتب العديد من القصائد التي تُعبر عن رؤيته الشعرية الفريدة، والتي جُمعت في ديوانه "أحلام الفارس القديم" يُظهر فيها قدرته على المزج بين الأسطورة والواقع، حيث يطرح من خلاله تساؤلات حول الهوية والوجود والبحث عن الحقيقة، فهو ليس مجرد شاعر تقليدي بل تتجاوز أعماله حدود المألوف لتقدم تأملات فلسفية عميقة حول الحياة والموت والحب.
يقول عبد الصبور في مفتتح ديوانه "معذرة يا صحبتي ، لم تثمر الأشجار هذا العام، فجئتكم بأردأ الطعام، ولست باخلاً، وغنما فقيرة خزائني، مقفرة حقول حنطتي.
معذرة يا صحبتي، فالضوء خافت شحيح ، والشمعة الوحيدة التي وجدتها بجيب معطفي، أشعلتها لكم...، لكنها قديمة معروفة لهيبها دموع.
معذرة يا صحبتي، قلب، من أين آتي بالكلام الفرِح.
وضم هذا الديوان العديد من القصائد والتي بدأت بكلمه أغنية وهي "أغنية للشتاء"، و"أغنية للقاهرة"، و"أغنية الليل"، و"أغنية على الله"، و"أغنية من فيينا".. تلك الأغاني التي لم تكن بالأغاني بل هي لحن حزين قد يبكيك وقد تجد نفسك تعيش معه نفس المشاعر ففي أغنية للشتاء يقول: "ينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدي، ذات شتاء مثله، ذات شتاء، ينبئني هذا المساء أنني أموت وحدي، ذات مساء مثله، ذات مساء، وأن أعوامي التي مضت كانت هباء، وأنني أقم في العراء".
أما في القصيدة التي حملت اسم الديوان "أحلام الفارس القديم" فيقول: "لو أننا كغصني شجرة، الشمس أرضعت عروقنا معا، والفجر روانا ندي معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة، حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف، نخلع الثياب، نعري بدنا، ونستحم في الشتاء، يدفئنا حنونا".
إن التأثير الذي تركه صلاح عبد الصبور في الأدب العربي لا يمكن تجاهله، فقد ساهم في تشكيل الوعي الثقافي العربي الحديث من خلال إبداعاته التي تميزت بالجرأة والعمق. إن النظر إلى أعماله يتطلب منا تقدير الجهد الذي بذله في خلق حالة من التوازن بين التقليد والحداثة، وبين الالتزام بالتعبير عن الطموحات الفردية والجماعية على حد سواء. ففي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن صلاح عبد الصبور كان أكثر من مجرد "صاحب الكلمة"، بل كان صاحب رؤية أدبية وثقافية وفكرية ساهمت في إثراء الأدب العربي.
صاحب كلمة
إن التأثير الذي تركه صلاح عبد الصبور في الأدب العربي لا يمكن تجاهله، فقد ساهم في تشكيل الوعي الثقافي العربي الحديث من خلال إبداعاته التي تميزت بالجرأة والعمق، ما يجعلنا أن ننظر إلى أعماله بشكل عميق لكي نتعرف على الجهد الذي بذله في خلق حالة من التوازن بين القديم والحديث، وبين الالتزام بالتعبير عن الطموحات الفردية والجماعية على حد سواء، ففي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن صلاح عبد الصبور كان أكثر من مجرد "صاحب الكلمة"، بل كان صاحب رؤية أدبية وثقافية وفكرية ساهمت في إغناء الأدب العربي وإثرائه.
فيُعتبر " عبد الصبور" أيقونة ثقافية تُمثل التوازن بين التراث والحداثة، بين الشعر والمسرح، وبين الفكر والسياسة. إن دراسته تُسهم في فهم أعمق للتعقيدات الثقافية والسياسية التي شكلت العالم العربي في القرن العشرين.، ولهذا فإن دراسة أعماله، وعلى رأسها "مأساة الحلاج"، تُعد مفتاحاً لفهم التحولات الثقافية والسياسية التي ساهمت في تشكيل هوية الأدب العربي الحديث.
وربما نترك لبعض من قصائده التي قيلت سواء على لسان شخوص مسرحياته او في أبياته الشعرية التي تُعد طفرة في تجسد الصورة، فمن القليل ان تشاهد القصيدة وكأنها لوحة تشكيلة بها كل ألوان الحياة.. فأنت حينما تقرأ إحدى قصائده وكأنك تشهد شخوصها من لحم ودم تتحرك وتتمايل مع الرياح ومع فصول السنة .
ذاعت شهرته بعد نشر قصيدة «شنق زهران» وصدور ديوانه الأول «الناس في بلادى»
ففي قصيدة "الحب فى هذا الزمان" يقول عبد الصبور
"تَسْأَلُنِى رَفِيْقَتِى: مَا آخِرِ الطَّرِيْقْ
وَهَلْ عَرَفْتُ أَوَّلَهْ
نَحْنُ دُمًى شَاخصَهْ
فَوْقَ سِتَارٍ مُسْدَلَهْ
خُطًى تَشَابَكَتْ بِلاَ ..
قَصْدٍ عَلِى دَرْبٍ قَصِيْرٍ ضَيَقِ
اللهُ وَحْدَهُ الذِى يَعْلَمُ مَا غَايَةُ هَذَا الْوَلَهِ المُؤرِّقِ
يَعْلَمُ هَلْ تُدْرِكُنَا السَّعَادَهْ
أَمْ الشَّقَاءُ وَالنَّدَمْ ؟
وَكَيْفَ تُضَعُ النَّهَايَةُ المُعَادَهْ
المَوْتُ ... أَوْ نَوَازِعُ السَّأَمْ ؟
يُسَلِّمُونَ فِى فُتُورْ ...
يُدِّعُونَ فِى فُتُورْ ...
*******
الحُبْ يَا رَفِيْقَتِى ، قَدْ كَانْ
فِى أَوَّلِ الزَّمَانْ
يَخْضَعُ للتَرْتِيْبِ وَالحُسْبَانْ
" نَظْرَةٌ، فَابْتِسَامَةٌ، فَسَلاَمٌ
فَكَلاَمٌ، فَمَوْعِدٌ ، فَلِقَاءُ "
اليَوْمَ.. يَا عَجَائبَ الزَّمَانْ !
قَدْ يَلْتَقِى فِى الحُبِّ عَاشِقَانْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَسِمَا
ذَكَرْتِ أَنَّنَا كَعَاشِقَيْنْ عَصْرِيَّيْنِ ، يَارَفِيْقَتِى
ذُقْنَا الذِى ذُقْنَاهْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَشْتَهِيْهْ
وَرَغْمِ عِلْمِنَا
بِأَنَّ مَانَنْسِجَهُ مُلاءَةً لِفَرْشِنَا
تَنْقُضُهُ أَنَامِلُ الصَّبَاحْ
وَأَنَّ مَا نَهْمِسُهُ، نُنْعِشُ أَعْصَابَنَا
يَقْتُلُهُ البُواحْ
فَقَدْ نَسْجْنَاهُ
وَقَدْ هَمَسْنَاهُ
وهنا يأخذنا عبد الصبور في تلك القصيدة في رحلة يبدو أنها عن الحب ولكنها تعبر عن ماساه الإنسان وانهزامه وكسرته أمام التغيرات الاجتماعية والإشكاليات السياسية والهزيمة والكسرة كل تلك الهزائم التي قد تفرط قيودًا على الحب وتحول دون أن يجتمع الأحبة، فالحب في هذا الزمان قد يكون سجنًا وقيدًا للعاشقين .
حيث تتعمق مأساة الحب لدى "عبد الصبور" حينما يتحول الإنسان إلى مجرد دمى جامدة لا تمتلك الإحساس بالحب، وأن الواقع وزيفه يحيل دون تحقيق رغبة الشاعر في الوصول إلى الحب الحقيقي والصادق وصاف، ويقول الدكتور صبري حافظ: "إن زيف الواقع وتبعثر الأحلام فيه وتناثرها مزقاً وأشلاءً، ووقوع فرسانه أسرى قضبان الصمت، وسيطرة المواضعات الجائرة على ظروفه الحضارية، وإحساس الشاعر بالاغتراب عن تنعمات المدينة وعن الدور الحقيقي للشعر والكلمات، وتمزقه إزاء هذا الوضع الراعب المذل كل هذا خلق في أعماق فارسنا توقًا عميقًا، صادقًا وصوفيًّا إلى واحة ضئيلة من العواطف البريئة الصافية".
المناصب القيادية
تقلد "عبد الصبور" العديد من المناصب المهمة خلال مسيرته، حيث أسهم بشكل كبير في تطور الأدب والفكر العربي. بدأ مشواره المهني كمعلم للغة العربية، مما أتاح له فرصة للتفاعل مع الشباب ونقل أفكاره إليهم، وفيما بعد، عمل كمحرر في عدد من المجلات الأدبية والثقافية، حيث ساهم في إثراء الساحة الثقافية العربية بمقالاته النقدية والفكرية.
كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة "الكاتب"، التي كانت منبرًا مهمًا للمثقفين والمفكرين في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تولى عبد الصبور منصب رئيس الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 1979 حتى وفاته في 15 أغسطس سنة 1981، مما أتاح له الفرصة للتأثير بشكل مباشر على حركة النشر والتوزيع في العالم العربي.
وخارج نطاق الأدب، عمل عبد الصبور في السلك الدبلوماسي، حيث شغل منصب المستشار الثقافي في الهند، وهو الدور الذي أثرى تجربته الثقافية وأتاح له التعرف على كنوز الفلسفات الهندية وثقافات الهند المتعددة، مما انعكس على كتاباته وأفكاره.
من خلال هذه المناصب، لم يكن صلاح عبد الصبور مجرد كاتب أو شاعر، بل كان شخصية محورية في تشكيل المشهد الثقافي العربي في القرن العشرين، حيث ساهم في بناء جسور بين الأدب والفكر والسياسة.