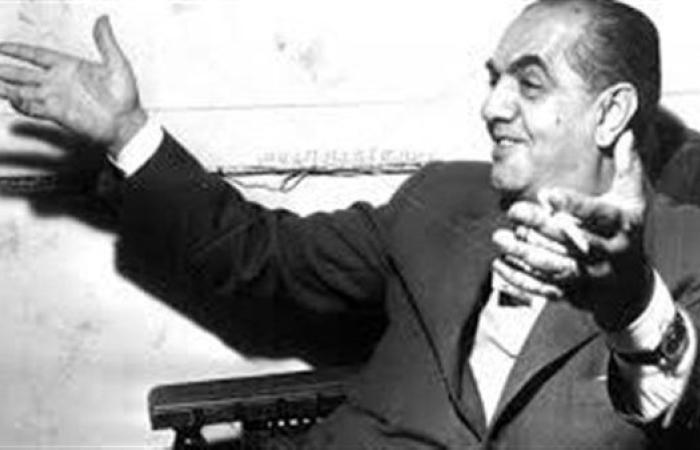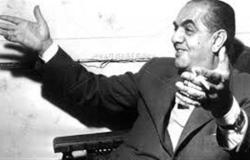كان محمد عبد المطلب، فى صوته ولهجته واختياره لكلماته، أشبه بمندوب دائم للمشاعر المصرية فى هيئة الغناء. لم يكن مطربًا يتفنن فى الأداء وحسب، بل كان مرآة شفافة تُظهر ما تخفيه الأزقة، وتستعيد بنغمة واحدة تفاصيل البيوت، والحكايات، والأحلام المؤجلة. فى صوته دفء الحارة، وصدق البسطاء، وتنهيدة الوطن حين يُحبّ ويُخذل.
نكتب اليوم عن عبد المطلب لا كفنان مرّ بصالة الطرب، بل كحالة ثقافية واجتماعية شكّلت وعينا الجمعي. نكتب عن الطفل الذى نشأ فى حى شبرا الشعبي، ليصبح الصوت الذى يشبه الحي، ويُشبه أهله. نغوص فى أصوله، ونُضيء كيف أثّرت نشأته فى اختياراته الغنائية، وفى انحيازه غير المعلن للشارع، لا للصالونات.
نتوقف كذلك عند أغانيه التى تسللت إلى نسيج الوطنية المصرية بلا شعارات، بل بروح المحبة والانتماء؛ عند "ساكن فى حى السيدة" كأغنية لا تصف حيًا بل ترسم خريطة وجدانية لمصر، وعند "يا حبيبتى يا مصر" حين كانت لا تزال تخرج من الحناجر لا من الخُطط الإعلامية.. ولا ننسى أغنية "ياسايق الغليون عدى القنال" التى غناها عقب تأميم قناة السويس، وكتبها صلاح جاهين ولحنها محمود الشريف.. تقول كلماتها: يا سايق الغليون عدى القنال عدى، وقبل ما تعدى، خد مننا وادى، دا اللى فحت بحر القنال جدى، عدى عدى ياسايق الغليون / بحر القنال يا كترها رماله، وجدنا فوق الكتاف شاله، بحر القنال اتبدلت حاله، وجدنا متهنى بعياله / واحنا على الشطين مفتحين العين، عارفين طريقنا منين / عدى عدى ياسايق الغليون.
خرج من حوارى شبرا ليستقر في ذاكرة الوجدان الجمعي
مندوب دائم للمشاعر المصرية
فى هيئة الغناء ومرآة شفافة تستعيد بنغمة واحدة تفاصيل البيوت والحكايات والأحلام المؤجلة
وأداها عبدالمطلب بأدائه المعهود كلحن شجى يتسلل إلى الإنسان ويسمو بمشاعره ويجعله يفخر بقرار تأميم القناة وعودة الحق لأصحابه.
كان الغناء الشعبي فنًّا يعبّر عن الناس. فما بين أغنية كانت تُولد فى بيت صغير وتعيش عمرًا طويلًا، وأغانٍ تُصنع في استوديوهات سريعة وتُنسى فى أسبوع، يظهر الفارق بين الطرب كفن والطرب كسلعة.
في النهاية، نُعيد قراءة عبد المطلب كأرشيف صوتيّ لذاكرة مصر. فى أغنيته "تسلم إيدين اللى اشترى"، حكاية عن الفرح البسيط حين كان يُصنع بأقل القليل. وفى صوته، ذلك الحنين الذى يجعلنا نبتسم في الوجع ونذرف دمعة وسط ضحكة. لأنه لم يكن يغنى وحده... كانت مصر تغنى معه.
النشأة الشعبية وبذور الانتماء
وُلد محمد عبد المطلب في بدايات القرن العشرين وبالتحديد يوم ١٣ أغسطس ١٩١٠ فى شبراخيت بمحافظة البحيرة، ثم انتقل إلى القاهرة عام ١٩٣٢ ليعمل مع محمد عبد الوهاب كـ"كورس" فى فرقته، إلى أن غنى منفردًا في مسرح بديعة فى العام نفسه.. وفى القاهرة، عاش فى حى شبرا، أحد الأحياء العريقة التى تمثّل نموذجًا حيًا لمزيج الطبقة الوسطى والدنيا فى القاهرة.. شبرا لم تكن مجرد مكان سكن، بل بيئة متكاملة تتقاطع فيها الأديان والثقافات، وتنبض فيها الحياة الشعبية بكل تجلياتها من الأسواق والمقاهى إلى الأفراح والمآتم. فى هذا المناخ المفتوح، تربى عبد المطلب وتكوّنت شخصيته الفنية والاجتماعية.
لم يكن فى بيت عبد المطلب ترف أو غنى، لكنه كان غنيًا بالحكايات والموروثات، وبأصوات الباعة الجائلين والمقرئين فى الجوامع، وأغاني العوالم فى الليالي. هذه البيئة المشبعة بالتفاصيل اليومية خلقت لديه حسًا موسيقيًا فطريًا، جعله قادرًا فيما بعد على تحويل أبسط المواقف إلى لحن مؤثر أو أغنية تعيش طويلًا.
تعلم عبد المطلب فى "الكُتاب" واحتك منذ صغره بالناس البسطاء، وهو ما جعله واعيًا بطبائعهم، قريبًا من مفرداتهم. كان يسمع المواويل فى الأفراح الشعبية، ويشارك فى "التحطيب" والطقوس المرتبطة بالمولد والسوق والحارة، وظلت هذه الصور حاضرة فى ذهنه، وانتقلت بصيغ موسيقية تلقائية إلى معظم أعماله.
ما ميّز نشأة عبد المطلب أنها صنعت فيه فنانًا ابن بيئته، لا متعالٍ عليها ولا متصنّع. لم يحاول يومًا التبرؤ من جذوره أو الانسلاخ عنها ليبدو أكثر "رقيًا"، بل آمن أن العمق الحقيقي يكمن فى الصدق والبساطة، وأن الغناء للناس لا يكون إلا من بينهم.
وحين بدأ طريقه الفني، لم يختَر القوالب النخبوية أو الأغاني المعقدة، بل فضّل دائمًا أن يبدأ من حيث يشعر، من صوت الجارة التى تغنى وهى تكنس، أو بائع العرقسوس الذى ينادى بطرب، أو سيدة تقرأ الدعاء من الشباك.. تلك هى بدايته وتلك كانت رسالته.
عبد المطلب والمزاج الوطني الشعبي
رغم أن محمد عبد المطلب لم يكن محسوبًا على التيارات السياسية أو مشاركًا مباشرًا فى المشروعات القومية الكبرى كما كان الحال مع عبد الحليم حافظ أو أم كلثوم، إلا أن صوته كان يحمل طابعًا وطنيًا خالصًا، ينبع من التكوين الشعبي الصادق، ومن صميم الشارع المصري. لم يحتج عبد المطلب إلى هتافات مباشرة أو شعارات صاخبة، بل استطاع أن يُعبّر عن مصر كما يشعر بها الناس، لا كما تُراد لهم فى البيانات والخطب.
واحدة من أبرز تجليات هذا الحس الوطني الشعبي كانت فى أغنيته الشهيرة "ساكن فى حى السيدة"، التى وإن بدت فى ظاهرها غنائية عاطفية عن الحنين إلى المحبوبة، إلا أنها تتجاوز ذلك إلى التعبير عن انتماء لمكان بعينه، للحارة المصرية التى تجمع فى ملامحها الطيبة والعِشرة والعلاقات الإنسانية المتشابكة. الأغنية توثق لحالة وجدانية يعرفها كل من عاش فى أحياء مصر الشعبية، وتُظهر مدى اندماج عبد المطلب مع المكان والناس، باعتباره جزءًا منهم لا زائرًا عليهم.
كما قدّم أغنية بعنوان "يا حبيبتى يا مصر" بصوته الخاص قبل أن تعاد صياغتها وتُصبح نشيدًا وطنيًا بصوت عبد الحليم حافظ. النسخة الأولى كانت أكثر دفئًا، وأقل صخبًا، وأكثر التصاقًا بالناس العاديين الذين يحبون الوطن بلا تنظير، ويُغنون له كما يُغنون لأمهاتهم. لم تكن الأغنية دعائية، بل كانت عاطفية بطبعها، تقول ببساطة: "أنا بحب مصر.. مش أكتر"، وهو ما منحها قوة وصدقًا.
حتى فى أغانيه التى لم يُقصد بها وطنية صريحة، تجد روح مصر حاضرة.. فى "رمضان جانا"، على سبيل المثال، يحتفى بالمناسبة الدينية التى تجمع المصريين على الفرح والتكافل، وتُصبح فيها الشوارع ميدانًا للحنان الشعبي. وتحوّلت الأغنية مع الزمن إلى طقس وطنى رمضاني، تُغنى فى البيوت والأسواق وعلى شاشات التليفزيون، وتُشعر المستمع أن "الوطن" ليس فقط الحدود الجغرافية، بل أيضًا اللحظة المشتركة، والفرحة الجماعية.
عبد المطلب لم يُغنِّ لمصر بوصفها كيانًا سياسيًا، بل بوصفها "ست الحبايب"، بوصفها الحارة، والحبيب، والعيد، والشارع. غناؤه الوطنى لم يكن بصوت مرتفع، بل بنبرة دافئة تجيد احتضان القلوب. وربما لهذا السبب، بقى صوته يمثل "مصر الحقيقية" أكثر من كثيرين ممن تغنّوا بالوطن فى المناسبات، ونسوه فى التفاصيل.
الغناء الشعبى بين البساطة والعمق
لم يكن محمد عبد المطلب مطربًا يسعى إلى "الإبهار" الفنى أو المغامرات اللحنية المعقدة. بل اختار، بوعى كامل، طريق البساطة كخيار فنى وفكري. هذه البساطة لم تكن تقليلًا من شأن الفن، بل كانت ترجمة صادقة لروح الشعب، وانعكاسًا لفهم عميق للذوق العام. عبد المطلب أدرك مبكرًا أن ما يهم الناس ليس النوتات العالية ولا التراكيب الشعرية المتقعّرة، بل الإحساس، والصدق، والكلمة التى تلمس القلب من أول وهلة.
انظر مثلًا إلى أغنيته الشهيرة "الناس المغرمين"، والتى يقول فيها:
"الناس المغرمين.. بيكونو حنينين.. ويخافو ع الشعور
الصبر بيخلقوه.. والبال بيطولوه.. ويشوفو الضلمه نور
موش زييك يا جميل.. لا عندك بال طويل
ولا بتدارى الامور
و شاكينى لكام عزول.. بقا هى دى الأصول
د انا عندى حق أقول.. الناس المغرمين.. ما يعملوش كدا"
كلمات بسيطة، لكن فيها من الحكمة والتأمل فى طبيعة الحب ما يصعب اختصاره فى عشرات الأبيات. عبد المطلب لم يكن يُغنّى ليثير الإعجاب، بل ليحاور قلوب الناس مباشرة، دون وسائط من البلاغة الزائدة أو الأداء المسرحي.
وفى مقارنة عادلة بينه وبين مطربين شعبيين معاصرين له، يبرز عبد المطلب كصوت استطاع الحفاظ على شخصية موسيقية مستقلة. فبينما مال كارم محمود إلى الكلاسيكية بصبغة شعبية، واقترب شفيق جلال من الغناء الشعبى البحت، وقف عبد المطلب فى منطقة خاصة به: لا هو نخبوى يُغنّى للصالونات، ولا هو "أفراحجي" يُغنّى للحظات عابرة. بل هو صاحب مشروع صوتى يعكس المجتمع ويحترمه.
أما أغنية "شفت حبيبي" لعبد المطلب فتتضمن مقاطع تعبر عن الفرحة والبهجة بلقاء الحبيب. تبدأ الأغنية بموال تقليدى (يا ليلى يا عيني) ثم تنتقل إلى وصف جمال الوصل بعد الوحدة، حيث يتحول القلب من وحيد إلى فرحان. تتضمن الكلمات أيضًا التعبير عن الشوق والحنين للقاء الحبيب الذى يجلب السعادة والنعيم.
تتميز الأغنية بعدة سمات موسيقية وتعكس جوها العاطفى والنبطي. ومن أبرز سماتها:
استخدام لحن نبطى تقليدي، وهو نوع من الموسيقى العربية الأصيلة التى تعتمد على المقام والأنغام العربية الأصيلة، مما يعطيها طابعًا فريدًا وارتباطًا بالتراث العربى الأصيل.
كما تتسم الإيقاعات المستخدمة بالثبات والبساطة، مما يسمح للمستمع بالتركيز على الكلمات والمشاعر التى تنقلها الأغنية، ويخلق جوًا من الهدوء والطمأنينة.
هذا إلى جانب تميز عبد المطلب بصوته العذب والهادئ، وهو يكتفى غالبًا بأداء هادئ وأسلوب متزن، مما يعزز من التأثير العاطفى للأغنية ويبرز عمق المشاعر.
كما أن الموسيقى تخلق أجواء من الحنين والاشتياق، مع التركيز على الجوانب العاطفية، لدفع المستمع للشعور بالمحبة والشوق.
عبد المطلب لم يُغنِّ من موقع الأستاذية، بل من موقع المشاركة. أغانيه كانت "جلسة صفا" بينه وبين جمهوره، فيها الحزن وفيها الأمل، فيها الفقد وفيها الوصل، دون افتعال أو استعراض. لذلك ظل، رغم بساطة ألحانه وكلماته، فنانًا ثقيل الوزن، يُعيد التذكير بأن "العمق الحقيقي" قد يكون مغمورًا فى أبسط جملة، وأجمل لحن، وأقرب نبرة.
الرسائل الخفية فى أغانيه
لم يكن محمد عبد المطلب مجرد مطرب يؤدى كلمات ولحنًا، بل كان ناقلًا أمينًا لمشاعر الجماهير وهواجسهم الدفينة. كثيرٌ من أغانيه حملت رسائل تتجاوز معناها المباشر لتغوص فى أعماق النفس الشعبية، وتعكس أبعادًا اجتماعية ونفسية شديدة الرهافة. أغنيته الشهيرة "رمضان جانا" ليست فقط نشيدًا احتفاليًا، بل تحوّلت إلى ما يشبه الوثيقة الصوتية التى تُعلن بدء الشهر الكريم، وتعيد تشكيل أجواء الحارة المصرية، وتُعزز الشعور الجمعى بالبهجة والتراحم، وكأنها بنداء شعبى موحّد يحتفل بقيم التضامن والكرم.
أما فى "ما بيسألش عليّا أبدًا"، فتنكشف القدرة الفريدة لعبد المطلب على التعبير عن الوحدة والخذلان بأسلوب بسيط لكنه نافذ. الأغنية ليست قصة عتاب عادية، بل حكاية إنسانية عن التعلق، والإهمال، والخذلان، كما يراه الإنسان البسيط الذى لا يملك سوى صوته ووجدانه ليعبّر بهما عن جرحه. ينجح المطرب هنا فى انتزاع التعاطف دون أن يستدر الدموع أو يصرخ بالألم، بل يكتفى بنبرة ناعمة وحنونة تُلامس القلب وتُشعر السامع أن الأغنية كُتبت له.
وفى أغنية "تسلم إيدين اللى اشترى"، لا يغنى محمد عبد المطلب فقط للحب والفرح، بل ينسج خطابًا اجتماعيًا دافئًا عن الاقتصاد فى الزواج، وتبسيط مراسمه، دون أن ينتقص ذلك من البهجة أو الجمال. الأغنية تقدّم صورة لعريس بسيط، اشترى "الدبلتين والإسورة"، فاعتُبر هذا وحده كافيًا لإشعال الفرح وتفجير الزغاريد. لا ذهب غاليًا، ولا مهر فاحش، بل لمسة محبة وتقدير، تسدّ عن القناطير المقنطرة.
حين يقول عبد المطلب: "أنا لما دريت من فرحتى جيت، وهأقدم من عندى هدية، دستة مناديل منظرها جميل، مع تحفة من الورد وصيّة"، فهو لا يغنّى للماديات، بل يمجّد الرضا. الهدية ليست ثمنًا، بل رمزًا؛ والمناديل ليست فاخرة ولا مرصعة، لكنها جميلة بعين القلب. هنا تتجلى فلسفة الفرح الشعبي: السعادة لا تحتاج إلى تكلّف، بل إلى نية صافية، وقلوب متصالحة مع بساطة الحياة.
ويمضى ليقول: "راح أجيب عقدين وسبع فساتين، وعشر ورقات حنة وسكر"، فتغدو مفردات البهجة فى الأغنية أقرب إلى قائمة احتياجات عرس شعبى فى حارة مصرية، حيث لا مكان للبذخ، لكن الفرح يملأ الزوايا. الاقتصاد فى "الشبكة" لا يُفسد الفرح، بل يجعله أقرب إلى الناس، وينزع من الزواج طابعه الطبقى القاسي، ويعيده إلى أصله: مودة ورحمة وستر. عبد المطلب، بصوته الشعبي، يقدّم درسًا اجتماعيًا: السعادة الحقيقية لا تُشترى، بل تُصنع من أبسط الأشياء.
اختيارات فنية نابعة من القلب
كان محمد عبد المطلب فنانًا يعرف جيدًا ماذا يريد أن يقول، ولمن. لم يكن غناؤه مجرد أداء، بل كان تعبيرًا صادقًا ينبض بالحياة، يتسلل إلى القلوب دون استئذان. ولهذا، لم يكن يقبل أى كلمات تُعرض عليه لمجرد أنها لشاعر كبير أو أنها مصاغة بلغة جزلة. كان يضع نصب عينيه جمهور "الشارع المصري"، البسيط والعميق فى آن، الذى يحب أن يسمع ما يفهمه، ويحس ما يغنيه المطرب من أول نغمة ومن أول سطر.
ذات يوم، عُرضت عليه قصيدة لأحد كبار الشعراء، فقرأها وتأملها ثم قال بصدق دون مجاملة: "أنا مش هعرف أغنى الكلام ده.. أنا عايز الناس تفهمنى من أول سطر".. لم يكن هذا تعاليًا على الشعر، بل وفاءً لنهجه الذى اختاره منذ بدايته: أن يكون قريبًا من الناس، ابنًا لصوتهم وأحلامهم ومواجعهم، لا ناطقًا بلغة لا تلمس وجدانهم.
ولعل تلك الفلسفة تتجلّى بوضوح فى قصة واحدة من أشهر أغنياته: "رمضان جانا". لم تكن الأغنية فى بدايتها كما نعرفها اليوم، فقد ظلت حبيسة الأدراج فترة من الزمن، لأن لحنها الأول جاء بطيئًا لا يعكس فرحة الشهر الكريم. لكن عبد المطلب لم يتخلَّ عنها، بل ظل يُطالب بتعديلها لتناسب روح البهجة التى تعم الشارع المصرى مع قدوم رمضان.
وبعد محاولات عدة، أُعيد توزيع اللحن ليصبح أكثر حيوية واحتفالًا، تمامًا كما تخيّله عبد المطلب. وما إن صدح بصوته بـ"رمضان جانا"، حتى صار صوته جزءًا من طقس الشهر ذاته، تسمعه الأذن فتبتسم الروح، وتدبّ الفرحة فى الزوايا.
من هنا نفهم أن اختيارات عبد المطلب الفنية لم تكن عشوائية، بل نابعة من ذوق صقله السمع والشارع والصدق. أراد دائمًا أن يكون صوته مرايا لما يعيشه الناس، ولهذا بقى صوته حيًّا رغم مرور السنين، لأن ما خرج من القلب لا يمكن إلا أن يستقر فى القلب.
الطرافة والحكايات خلف الصوت
لم يكن محمد عبد المطلب يضع بينه وبين الناس حجابًا، لا فى صوته ولا فى شخصيته. رجل فطري، نَشِط الروح، لا يُحب التكلّف، ولا يعرف طريقًا إلى الادعاء. وقد عبّر عن هذه البساطة ذات مرة بجملة صارت تُتَناقل كحكمة شعبية:
"أنا صوتى زى الطعمية... مش فخمة زى الكافيار، بس كل الناس بتحبها!"
لم تكن هذه العبارة مجرد طُرفة، بل كانت مرآة لنهجه الفنيّ كله. صوته، وإن لم يكن مذهبًا كالذهب، كان دافئًا كالرغيف البلدي، وحنونًا كصوت أمّ تُغنى لطفلها. لم يسعَ يومًا لأن ينافس أهل الطرب العالى فى الطبقات والتقنيات، بل اختار أن يكون صوته صوت الشارع، والقلوب المتعبة، والضحكة الخارجة من القلب.
ومثلما كان صوته قريبًا، كانت حياته كذلك مليئة بالحكايات التى تشبه حكاياتنا. من أشهر هذه القصص، تلك التى أحاطت بأغنيته "الناس المغرمين"، والتى لم تأتِ من وحى الخيال، بل من وحى الجُرح. يقال إنه كان يعيش قصة حبّ مشتعلة، انتهت بخيبة صامتة، فخرجت منه كلمات الأغنية كما تخرج الزفرة من صدر مكتوم.
"الناس المغرمين عاملين زينا..." لم تكن مجرد كلمات، بل كانت فضفضة حقيقية. حكاية رجل أحبّ ولم يُوفَّق، فاختار أن يحوّل وجعه إلى لحنٍ يُداوى به الآخرين. وربما لهذا ظلت الأغنية تعيش، لأنها كُتبت بالدمع لا بالحبر.
وما بين هذا المزاج الشعبى الخفيف، وتلك الجدية فى التعبير عن الحب والخذلان، تكوّنت شخصية عبد المطلب الغنائية: رجل لا يغنى من برجٍ عاجي، بل من طاولة مقهى، أو زاوية حارة، أو قلب موجوع. رجل يُضحكك بجملة بسيطة، ويبكيك بنغمة صادقة، لأنه قبل كل شيء... "زى الطعمية".
محمد عبد المطلب كحالة ثقافية خالدة
فى زمن تتبدل فيه الأذواق كما تتبدل الفصول، يظل صوت محمد عبد المطلب نهرًا صافيًا يتدفّق فى وجدان المصريين بلا انقطاع. بعد أكثر من نصف قرن على ذروة عطائه، لا تزال أغانيه تُذاع، لا بوصفها مجرد تسجيلات قديمة، بل كأنها رسائل حيّة من عصر أكثر دفئًا، وأكثر صدقًا. إن صوته لا يُستعاد فقط فى أمسيات الطرب، بل يتسلّل إلى تفاصيل الحياة اليومية: من راديو تاكسى يَشُق الزحام، إلى مشهد عابر فى مسلسل رمضاني، أو حتى إعلان تجارى يبحث عن مصداقية الزمن الجميل.
لقد تجاوز عبد المطلب كونه مطربًا شعبيًا إلى أن صار "رمزًا"، أشبه بصورة فوتوغرافية فى بيت الجدّة، أو رائحة الخبز الطازج فى صباح العيد. استُحضرت مقاطع من أغانيه فى الدراما والإعلانات، لا لمجرد استدعاء الحنين، بل لأن صوته اختزن فى نبراته مصر بكاملها: بأفراحها، وهمومها، وابتساماتها التى تشبه الغناء أكثر مما تشبه الواقع.. وإلى جانب أغانيه الخالدة، شارك فى عدة أفلام سينمائية، منها: ٥ شارع الحبايب، إدينى عقلك، ليلة غرام، لك يوم يا ظالم، وعلى بابا والأربعين حرامي.
هكذا، ظل عبد المطلب حالة فريدة، ليس فقط فى الغناء، بل فى الثقافة الشعبية ككل. إنه الصوت الذى لا يغيب، لا لأنه "كلاسيكي"، بل لأنه صادق. وحين يكون الصوت صادقًا، يصبح خالدًا.
صدى لا يخفت
محمد عبد المطلب هو ذلك الصوت الذى لا يُنسى، لأنه لا يُقلَّد. صوت يذكّرنا بمن نحن، وبماذا أحببنا، وبكيف كانت مصر حين كانت الأغنية تعبيرًا عن الحياة لا مجرد ترفيه. وحين يُذاع صوته فى "رمضان جانا"، أو "ساكن فى حى السيدة"، نبتسم، ونشعر أن هناك من غنى لنا، وعنا بصدق، وبدفء، وبدون رتو، فما يزال يمتعنا رغم رحيله فى ٢١ أغسطس ١٩٨٠.