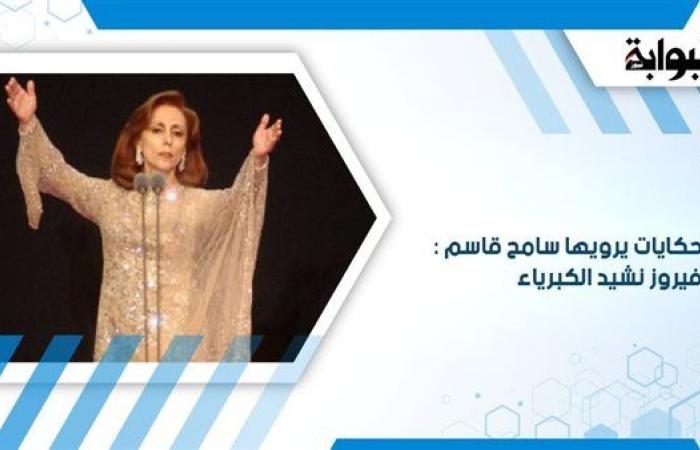فى عزّ الوجع، حين تغيب القدرة على التعبير، وتخون اللغة أهلها، يُولد نوعٌ آخر من النبل، نادرٌ كالعشب الذى ينبت على حافة صخرة. هكذا أطلت السيدة فيروز، لا كما تظهر النجمات فى وداع أحبّائهن، بل كما تظهر الرموز حين يختبرها الحزن الأقصى، ولا تنكسر.
لم تبكِ، لم تندب، لم ترفع صوتها أو تتكئ على كتف أحد، جلست بكامل كبريائها، كتمثال من شجنٍ وصبر، يستقبل العزاء فى ابنه. ذاك الابن الذى لم يكن مجرّد امتداد بيولوجي، بل امتدادٌ فنّى وإنسانى ووجودي، يحمل اسم زياد الرحباني، ويحمل معه تاريخًا من الأغنيات، من التمرد، من الشراكة، من النجاة التى وقفت إلى جانبها حين ترمّلت مبكرًا بفقدان عاصي. كان زياد الابن، والملحّن، والمشاكس، والذكى الذى أعاد صياغة صوتها من جديد، بعد أن ترمّل اللحن من موسيقى الرحابنة. وحين ودّعته فيروز فى كنيسة رقاد السيدة، لم تودّعه كأمٍّ تُفجع، ولكن كرمزٍ يُنتزع منه جزء من تاريخه، ويبقى واقفًا، لأن الوقوف هو الموقف الأخير للكرامة.
ما الذى يمكن أن نقوله عن امرأةٍ صمتها أعذب من خطب الفلاسفة، وحدادها أكثر بلاغةً من الأناشيد؟ كيف يمكن أن يُوصف مشهدٌ جلست فيه فيروز بثوبٍ أسود، فى صدر صالون عزاء، تستقبل المعزّين فى الابن الذى خاض بها مغامرة التجديد، والميلاد الثاني؟
إنها ليست مجرد أمّ حزينة، ولا مطربة عظيمة تودّع فنانًا آخر، هى صورة لبنان حين كان جميلًا، ومرآة الحلم العربى حين كان لا يزال ممكنًا، وصوتٌ نادر ما زال يُستعار فى كل شتاء ليحمل دفء الانتماء وسط الخراب.
هذا المقال ليس رثاءً، ولا سيرة تقليدية، لكنه محاولة للنظر طويلا فى امرأةٍ لم تقل إلا ما يستحق أن يُقال، ولم تغنِّ إلا ما يستحق أن يُغنّى، ولم تحزن إلا بصمتٍ يليق بالأيقونات.
من تلك اللحظة، حيث فيروز تودّع ابنها كما يودّع الوطن بعض أجزائه ويتظاهر بالقوة، ينطلق هذا المقال، ليغوص فى تجربة صوتٍ ليس كأى صوت، وسيرةٍ ليست كأى سيرة. من فيروز، الإنسانة، العاشقة، الزوجة، الأرملة، الأم، المبدعة، المنعزلة، الشامخة، نبدأ هذه الرحلة.
حين يُولد الصوت من الصمت
فى البدء، لم تكن فيروز سوى طفلةً خجولة فى حيّ متواضع من بيروت، اسمها نهاد رزق وديع حداد. لم تكن تعرف أن اسمها سيصير لاحقًا رمزًا لصباحات العرب، وأن صوتها سيُدرَس كما تُدرَس النصوص المقدّسة، وأنها ستمسى رمزًا لما تبقّى من الجمال وسط الخراب الذى يداهم الجميع.
وُلدت نهاد فى ٢١ نوفمبر من عام ١٩٣٥، لأب يعمل فى مطبعة بسيطة، وأمّ ريفية الجذور. كان البيت صغيرًا، قليل الضوء، محدود الوسائل، لكنه ممتلئ بحميمية الأُسر التى تعرف جيدًا كيف تعيش الفقر بكرامة. فى تلك البيوت، لا يعلو الصوت، ولا تُرفَع الشكاوى إلى السماء، ولكن يُدار الصمت كما تُدار المزامير، ويُختزن التعب فى العيون، ويُرسَل الأطفال إلى الحياة وهم محمّلون بأحلام لا تشبه أعمارهم.
لم تكن نهاد كثيرة الكلام، ولا من أولئك الأطفال الذين يصرخون للفت الانتباه. كانت تنصت. وكانت تملك أذنين لا تلتقطان الصوت فقط، أذنان تمتصّان ما خلفه: الشعور، الصدى، الهامس والمعلن، الحزن الخافت فى نبرة أمّها، الرجفة فى صوت رجل يبيع الخضار فى الحيّ، التنهيدة المتعبة من نوافذ الجيران، تراتيل الكنيسة، وتلاوة القرآن من المذياع.
فى تلك الأعوام الأولى، لم يكن أحدٌ يعرف أن هذه الطفلة الهادئة تخفى فى حنجرتها سِرًّا موسيقيًا، سيتحوّل لاحقًا إلى ظاهرة. لكنها كانت تعرف ـ على طريقتهاـ أن فى داخلها شيئًا لا يشبه أحدًا، شيئًا لا يُفصح عن نفسه بالكلام، بل ينتظر لحظة النشيد الأول ليولد كما تولد المعجزات.
فى المدرسة، لفتت انتباه الجميع بصوتها العذب وهى ترتّل فى الحصص الدينية. لا أحد درّبها، ولا أحد علّمها كيف تصعد وتنزل فى المقامات، لكنها كانت تفعل ذلك بفطرةٍ تُربك المتخصصين. أحد أساتذتها كتب فى تقرير صغير: "نهاد لا تصرخ، لا تعترض، لا تلعب كثيرًا، لكنها حين تغنّي، يتحول الصفّ إلى سكينة."
من هنا، بدأت الرحلة
حين التحقت بفرقة كورال فى إذاعة لبنان فى بداية الخمسينيات، كانت لا تزال فتاةً مراهقة، تحمل صوتًا أكبر من سنّها، وهدوءًا أكبر من العالم من حولها. كان العصر عصر الأصوات المرتفعة، من عبد الحليم إلى فريد الأطرش، من أم كلثوم إلى صباح. كلٌّ يغنى ليعلو، ليُسمَع، ليملأ المسارح. أما هي، فاختارت طريقًا معاكسًا تمامًا: أن تُسمِع العالم بصوتٍ خافتٍ، كالهمس فى الحلم، فيُصغى الناس لا لأن الصوت أعلى، بل لأن الشعور أعمق.
هناك، فى الإذاعة، التقت بشابٍ طموح اسمه عاصى الرحباني. لم يرَ فيها فتاة جميلة تُضاف إلى كورال النساء، بل رأى شيئًا لم يرَه من قبل. كان صوتها يشبه ندىً على غصن، أو صلاةً منسية فى دير. ومنذ اللحظة الأولى، بدأ مشروعٌ لم تعرفه الموسيقى العربية من قبل: مشروع الصوت الذى لا ينافس أحدًا لأنه فى مدارٍ مختلف.
عاصى قدّمها إلى شقيقه منصور، وبدأ الثلاثى فى كتابة تاريخ جديد. عندما غنّت فيروز أغنيتها: "حبّيتك بالصيف، حبّيتك بالشتا".. لم تكن مجرد جملة عاطفية، كانت إعلان ولادة لمدرسة موسيقية جديدة، فيها من الرهافة ما لا تحتمله الأذن العابرة، وفيها من التكوين الجمالى ما يُدهش العارفين.
ولأنها جاءت من الهامش، من أماكن لا تملك امتيازات الطبقة ولا رفاهية النشأة، جعلت من صوتها بوابة للفقراء والغرباء والحالمين والعاشقين والمكسورين. لم تغنِّ للترف، بل غنّت للنبض. غنّت "يا مرسال المراسيل" فى وقتٍ كان العالم العربى كله ينتظر مرسالًا لا يأتي، وغنّت "نطرتك أنا" وكأنها صوت كل امرأة انتظرت رجلًا لا يعود.
وهكذا، من الهامش بدأت، ومن القلب وصلت. من الصمت نشأت، وإلى الصمت عادت ـ فى استقبالها المعزين فى رحيل ابنها زياد، جلست بصمت نفس الطفلة التى كانت ترتّل فى صغرها، دون أن تنتبه أنها تُنشد للكون كله.
حين يكتمل الصوت بالرحابنة
فى لحظة فارقة من حياة نهاد حداد، الطفلة الهادئة التى حملت فى حنجرتها أرواح الملائكة، كان اللقاء الذى سيغيّر قدر الفن العربى إلى الأبد: لقاؤها بعاصى ومنصور الرحباني. لم يكن ذلك حدثًا عابرًا فى دفتر سيرة، كان أشبه باجتماع العناصر الأولى لتكوين كون جديد، حيث تلتقى الفطرة الغنائية المعجونة بالشجن مع الفكر الموسيقى الطليعى المشحون بالحلم الوطنى والرؤية الجمالية المتجاوزة.
كان عاصي، الأكبر بين الأخوين، رجلًا ذا عينين تلمعان كأنهما أبصرتا ما لا يبصره الآخرون. لم يكن موسيقيًا فقط، كان حالمًا، يرى فى الموسيقى خلاصًا من القبح، ويرى فى الفن نوعًا من المقاومة، مقاومة للبشاعة، للتكرار، للرداءة. وكان صوت نهاد حداد ـ التى صارت تُعرف داخل الإذاعة باسمها الفنى "فيروز" ـ هو الاكتشاف الذى شعر تجاهه بحسّ قدسي. كأنّ هذا الصوت لم يُخلق ليُغنى وحسب، بل ليجعل من الغناء طقسًا عميقًا يشبه الصلاة.
حين سمعها تغنّى لأول مرة، لم يسألها عن طبقة صوتها، ولا عن قدرتها على أداء مقام الصبا أو الرست. لم تكن المعايير التقنية هى ما أثار انتباهه، بل ما خلفها: النبرة الشفيفة التى تستطيع أن تنقل الحنين دون أن ترفع صوتها، وتقول الحب من دون أن تمسّ الابتذال، وتلامس الوطن من دون أن تتورّط فى الشعارات. كانت فيروز بالنسبة له صوتًا يملك القدرة على "تحويل الهواء إلى معنى"، كما وصفها لاحقًا أحد النقّاد الفرنسيين.
بدأ التعاون فورًا، وأثمرت الشراكة بين الصوت الرحبانى والصوت الفيروزى أغنية "عتاب" ثم "نحنا والقمر جيران"، وأغنيات أخرى صغيرة كانت بمثابة خطوات طفلٍ يتعلم المشى بثقة نحو الخلود. الرحابنة، بعقلهم التركيبى القائم على المزج بين التراث العربى والفكر الغربي، وجدوا فى صوت فيروز القالب الأنسب لتجريب رؤاهم الجمالية المتقدمة. بينما كانت أصوات أخرى تمضى فى تقليد الشرق الكلاسيكي، ذهب الرحابنة إلى نمط جديد تمامًا: القصيدة الغنائية القصيرة، ذات الجملة البسيطة الممزوجة بتوزيع موسيقى يدمج البزق مع الكلارينيت، والناى مع البيانو، والدفّ مع الكمان.
ثم جاء زواجهما فى منتصف الخمسينيات، ولم يكن زواجًا تقليديًا. لم تكن فيروز المرأة التى يختارها رجل لملء بيت، ولم يكن عاصى الرجل الذى يكتفى بشريكة حياة تقف خلفه. لقد كان زواجهما زواجًا بين العقل والجمال، بين الفن والحب، بين الصوت والفكرة. لم يكن من السهل على أى امرأة أن تتزوج من فنان بمزاج عاصي، ولا على أى رجل أن يتعامل مع امرأة تمتلك هذا القدر الهائل من الحضور والتأثير الجماهيري. لكنهما فعلاها، وتَشاركا الحياة والفن، وكأن كل مشروع رحبانى كبير لم يكن ليستوى لولا هذا التوازن الدقيق بينهما.
فى المسرح الرحباني، كانت فيروز البطلة الدائمة، لكنها لم تكن تُؤدى كما تؤدى الأدوار عادةً. لم تكن "تمثّل"، بل كانت "تتجلّى". فى "بياع الخواتم"، وغيره من الأعمال، كانت تجسّد شخصية الوطن، الحبيبة، الأم، الأمل، الحلم، الحزن، الغياب. لم تكن شخصياتها تحمل أسماءً فقط، بل كانت رموزًا: "ريا"، "نزهة"، "ياسمين"، كلها وجوه للأنثى الكبرى، للأنثى التى تمثّل الأرض اللبنانية فى عمقها الوجداني، لا فى صورتها الجغرافية.
وكانت الجملة الغنائية الرحبانية، أقصر من تلك التى كانت تقدمها أم كلثوم، لكنها أغزر دلالة. بدلًا من الملحمة، اختاروا الأغنية القصيرة، مثل "كان عنا طاحونه"، أو "رجعت الشتوية"، أو "أنا لحبيبي". تلك الأغنيات، التى لا تتجاوز الدقائق القليلة، كانت قادرة على قول ما لا تقوله المعلقات. ومعها، أصبح المستمع العربى لا يسمع صوتًا فحسب، وإنما يسمع لبنانًا آخر: لبنان الشاعر، لا السياسي. لبنان المهاجر، لا المقاتل. لبنان الحنين، لا الجراح.
كان من الطبيعى أن تنشأ الخلافات بين عاصى وفيروز لاحقًا، بين رجلٍ يرى العالم من عدسة عبقريته، وامرأةٍ ترى العالم من وجدانها الخالص. لكن الغريب أن تلك الخلافات، رغم مرارتها، لم تعكّر صفو الفن. حتى فى لحظات الانفصال، ظلّت الشراكة قائمة بصيغة أخرى. فقد فهم كلٌّ منهما أن بينهما شيئًا لا يمكن أن يتفكك بالكامل، لأنه ليس عقدًا ولا علاقة، بل مصير.
وبعد وفاة عاصى فى ١٩٨٦، لم تخرج فيروز بالبكاء، لم تُجر مقابلات تتحدث فيها عن الفقد، فقد اكتفت بالحضور فى جنازته كجبل. وقفت هناك، شامخة كما اعتادت، بصمتٍ لا تليق به إلا الأساطير. لم تكن أرملة رجل، كانت وداعًا لمرحلة، وخروجًا من ظلّ الأب الروحى إلى الضوء الخاص بها. من هنا بدأت مرحلة أخرى، مرحلة فيروز ما بعد الرحابنة، حيث ستتولى قيادة نفسها، ويصبح زياد الرحبانى امتدادًا آخر لتلك الرؤية، ولكن بشكل مختلف.
لكن قبل زياد، قبل الصراعات، قبل الانقسامات، كان عاصي. وكان منصور. وكان الحلم الذى بنوه معًا، بالأغنية، بالمسرح، بالوطن.
كانوا معًا ـ لا كثلاثة فنانين فقط، بل كثلاثة قديسين خرجوا من غار النور وقرروا أن ينقلوا للناس بشارة الجمال.
فى الحرب.. حين غنّت بيروت بصوتها
حين انفتحت شرايين المدينة على رائحة الدم، وكانت بيروت تلوّح لنفسها كأنها تودّع مرآتها، ظهرت فيروز فى أبهى تجلياتها الإنسانية والفنية. لم تكن الحرب الأهلية اللبنانية التى اندلعت عام ١٩٧٥ حدثًا عابرًا فى مسيرة وطن صغير، كانت زلزالًا أخلاقيًا وثقافيًا زعزع كل المفاهيم وأربك كل الثوابت. تحوّلت الشوارع إلى جبهات، والمنازل إلى متاريس، والأغنيات إلى صرخات أو شعارات، إلا صوت فيروز.. ظل وحده، نقيًّا، راسخًا، كأنّه المنفى الوحيد الذى يمكن الإقامة فيه من دون خجل.
فى ذلك الوقت، انقسم لبنان حتى نخاعه: بين اليمين واليسار، بين الشرق والغرب، بين الطوائف والمذاهب، بين الأشقاء والخصوم. صمت كثيرون، وتورط كُثر، وغرق الفن فى مستنقعات السياسة، إلا فيروز.. صمتها كان موقفًا، وحيادها كان مقاومة، وغيابها كان حضورًا أعلى.
فى تلك السنوات العاصفة، لم تغب فيروز تمامًا، بل كانت كالنور المتقطع فى العاصفة. اختارت أن تغنى لبيروت، لا لمن يقاتل فيها. من أشهر ما غنّت فى تلك الحقبة أغنيتها الخالدة: "لبيروت من قلبى سلام لبيروت"، هذه الأغنية التى كتبها جوزيف حرب، ولحّنها زياد الرحباني، لم تكن مجرد نشيد رثاء لمدينة تُقصف، كانت نشيد خلود لمدينة عصيّة على الموت. غنّت للمدينة التى كانت تُذبح بالسكاكين الطائفية، بوجدان من رآها تضحك فى الصباحات القديمة. لم تذكر بندقية، ولا راية، بل البحر، والأشجار، والناس العاديين الذين كانوا يحلمون فقط أن يعودوا إلى بيوتهم دون أن يحملوا أكفانهم فى جيوبهم.
وقد رفضت فيروز، فى تلك الحقبة، كثيرًا من العروض لإحياء حفلات فى الخارج، خصوصًا فى الدول العربية التى كانت تتقاسم النفوذ السياسى على لبنان. كانت ترى أن الغناء فى زمن الخراب يجب أن يكون شهادة على الألم، لا مجرد احتفال على مسرح مكيّف بالتصفيق. لذلك اختارت العزلة، اختارت أن تحتفظ بكرامة الفن فى عصر امتهانه. كانت الصامتة الكبرى، لكن فى صمتها كل الدلالات، وكل الرفض، وكل المحبة الجريحة.
وإذا كانت بعض الأصوات اللبنانية قد اختارت الانتماء إلى ميليشيا، أو التحريض ضد ميليشيا أخرى، فإن فيروز اختارت الانتماء إلى لبنان الجريح بكرامة، لبنان النور والموج والصنوبر، لا لبنان السلاح والخراب. لم تركع لأى زعيم، لم تُمجّد أى راية غير راية الجمال. ولذلك بقيت للجميع، بقيت "فيروز الوطن"، كما وصفها كمال جنبلاط ذات مرة.
حتى الذين اختلفوا على كل شيء، اتفقوا على فيروز. كان صوتها، وحده، يجمعهم حين لا يجمعهم وطن. كان الجنود المتحصّنون فى الجبال يستمعون إلى صوتها فى الليل كما يستمع الطفل إلى صوت أمّه من خلف الباب. وكانت تنبعث من مذياع مهترئ، داخل خيمة، لتذكّرهم أنهم لم يولدوا للقتل فقط، بل للحب، ولأن يكون لهم بيت، وأغنية، ونافذة مشرعة على الضوء.
صوتها للقدس.. حين كانت الحناجر من ذهب
من بيروت المجروحة إلى القدس الأسيرة، سافر صوت فيروز، لا على جناح الطائرات، بل على جناح النبوءة. لم تكن أغنياتها للقدس مجرّد تضامن عاطفى أو ردة فعل على نشرة أخبار، كانت بيانًا وجدانيًا صادرًا عن القلب العربي، الذى وإن أنهكته الحروب، لم ينكسر فى حضرة المدينة التى تسكن فى العمق: القدس.
فى زمن تواطأ فيه كثيرون بالصمت، وارتضى كثيرون أن يقايضوا الحرف بالمصلحة، جاءت فيروز كشجرة سنديان فى مهبّ الريح، لا تنحني، ولا تهادن، ولا تساوم. لم تنتظر مهرجانًا ولا كاميرا لتعلن موقفها، لكنها جعلت من المسرح منبرًا، ومن الأغنية مرثية ومقاومة.
غنّت للقدس فى وقت كان البعض يلمّعون أسماءهم فى بهو السفارات، وكانت هي، تكتب على الجرح العربى بيتًا من شعر وتبنى عليه موالًا من دمع. من أشهر ما غنّت، أغنيتها الخالدة: "زهرة المدائن": "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي، لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي..."
فيروز فى أغنياتها عن القدس لم تضع مسافة بين المسيح ومحمد، ولا بين الكنيسة والمسجد، لكنها جعلت من المدينة نقطة تلاقٍ روحى عظيم، مهدًا للأنبياء، ومرفأ للقلوب العاشقة للحقيقة.
ولهذا، لم يكن مستغربًا أن يتحول صوتها إلى نشيد يومى فى المنازل الفلسطينية. فى باحات المدارس، فى شاحنات المهجّرين، فى الزنازين، فى مخيّمات الشتات.. كان صوتها هناك، شاهدًا على جريمة كبرى لا تسقط بالتقادم، ومواساةً لمن لم يجد غير الحنين وطنًا بديلًا.
غنّت فيروز للقدس من قلبها، لا من فوق المنابر. لم تبتزّ الشعور القومي، لم تسقط فى فخّ الشعارات، بل قدّمت للفن أسمى ما فيه: القدرة على أن يُحبّ دون مقابل، وأن يَصْدُق دون ضجيج.
الرحيل.. وعندما يتوقف الزمان
فى رحيل زياد، لم تودّع فيروز ابنًا فحسب، بل ودّعت امتدادًا عميقًا من حياتها الفنية والوجدانية. ذلك الابن الذى كان شريكًا فى عبور الجراح، ورفيقًا فى زمن الانكسار، والذى حمل فى روحه صدى ألحان الرحبانيين، وتمردَ على القالب، ليكتب موسيقاه كما يكتب الشاعر الجريح حبره على نصل السكين.
هل كانت تبكى زياد؟ أم تبكى نفسها؟ أم تبكى هذا العالم الذى لم يترك لها إلا الذكريات؟