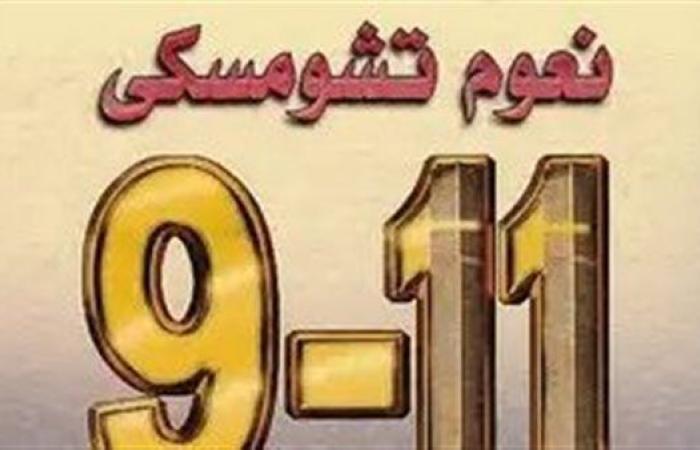حين هزّت هجمات الحادي عشر من سبتمبر العالم في خريف 2001، لم يكن وقعها على الولايات المتحدة شبيهاً بأي حدث سابق في تاريخها الحديث. فقد شكلت ضربة غير متوقعة لمركزها الاقتصادي والعسكري، وأدخلت العالم في مرحلة جديدة من السياسات الأمنية والعسكرية. في هذا المناخ المشحون بالخوف والغضب، ساد خطاب رسمي وإعلامي أمريكي أحادي يختزل الأزمة في صراع بين "الخير" و"الشر"، ويمهّد لسياسات خارجية قائمة على الردع العسكري والتدخل الوقائي.
في خضم هذه الأجواء، جاء كتاب نعوم تشومسكي "9-11" كصوت مختلف، بل ومزعج للتيار العام. فبينما اصطفّ أغلب المثقفين والإعلاميين خلف القيادة الأمريكية، اختار تشومسكي أن يقف في موقع الناقد الجذري للسياسات الإمبراطورية. لم ينشغل فقط بوصف المأساة من الداخل الأمريكي، بل سعى إلى إعادة وضعها في سياق عالمي يكشف جذور العنف المتبادل وعلاقات القوة غير المتكافئة التي طبعت النظام الدولي لعقود.
قوة هذا الكتاب لا تكمن فقط في سرعة صدوره بعد أسابيع قليلة من الأحداث، بل في جرأته على مساءلة المسلمات في لحظة بدا فيها النقد أقرب إلى "خيانة وطنية". ومن هنا، مثّل "9-11" تدخلاً فكرياً عاجلاً يعيد التذكير بأن التاريخ لا يبدأ في نيويورك أو واشنطن، وأن ما عاشته الولايات المتحدة من صدمة عاشته شعوب أخرى من قبل، ولكن في صورة قصف وحروب وتدخلات خارجية كانت واشنطن غالباً طرفها الفاعل.
بهذا المعنى، لم يكن الكتاب مجرد تحليل للأحداث، بل محاولة لإعادة تفكيك الخطاب الأمريكي وكشف مفارقاته الأخلاقية والسياسية. فبينما تحدثت واشنطن عن الحرية والعدالة، كان تاريخها مثقلاً بدعم الانقلابات والاستبداد. وبينما أعلنت الحرب على الإرهاب، أسهمت سياساتها في تغذيته. هذه الرؤية النقدية هي ما جعلت "9-11" نصاً أساسياً في فهم ما بعد الهجمات، ليس من زاوية اللحظة الآنية، بل من منظور النظام الدولي وصراع الهيمنة.
تفكيك الخطاب الأمريكي بعد الهجمات
رأى تشومسكي أن الولايات المتحدة تعاملت مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر باعتبارها حدثاً استثنائياً لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وكأن العالم دخل مرحلة جديدة مع سقوط برجي التجارة العالمية. هذا التوصيف، في رأيه، يخفي خلفه نزعة مركزية أمريكية تجعل من التجربة المحلية معياراً لقياس التاريخ بأسره، متجاهلة أن العنف السياسي والإرهاب الدولي لم يولد في تلك اللحظة. بالنسبة لتشومسكي، كانت الصدمة الأكبر بالنسبة للأمريكيين هي اهتزاز صورة "الحصانة الجغرافية" التي ظلت بلادهم تتمتع بها لعقود طويلة.
يشير الكاتب إلى أن ما اعتبرته واشنطن "غير مسبوق" عاشته شعوب عديدة من قبل، لكن بوجه معكوس؛ أي على يد السياسات الأمريكية ذاتها. فالهجمات الجوية والصواريخ بعيدة المدى والقصف الكاسح ليست جديدة على شعوب فيتنام أو أمريكا اللاتينية أو العراق. الفرق الوحيد أن الولايات المتحدة كانت دائماً هي الطرف الفاعل لا المتلقي، وبالتالي لم تُختبر من الداخل بقدر ما فرضت قوتها على الآخرين. هذا التناقض يكشف عن فجوة في الخطاب الأمريكي بين تصور الذات كضحية وتاريخها كقوة مهيمنة.
من هنا، يسلط تشومسكي الضوء على البنية الخطابية التي أحاطت بالهجمات، حيث صُوّرت الولايات المتحدة ككيان بريء يتعرض لعدوان غير مبرر، في حين أن هذا التصور يتجاهل عقوداً من التدخلات والانقلابات والدعم للأنظمة الاستبدادية حول العالم. بهذا الخطاب، حاولت واشنطن تقديم نفسها للعالم على أنها الضحية الأولى والأخيرة للإرهاب، وهو ما اعتبره تشومسكي إعادة إنتاج لرواية "البراءة الأمريكية" التي تشرعن لاحقاً الردود العسكرية والحروب الوقائية.
بالتالي، ينزع تشومسكي عن الرواية الأمريكية هالة التفرد والبراءة المطلقة، ويضعها في سياق أوسع من التاريخ الدولي للعنف. فالحدث، وإن كان مأساوياً، لم يكن جديداً على الإنسانية بقدر ما كان جديداً على الولايات المتحدة نفسها. بهذا التحليل، يفتح المجال لإعادة قراءة 11 سبتمبر ليس فقط كعملية إرهابية، بل كجزء من حلقة أوسع من العنف المتبادل، حيث تتحول الضحية والجلاد أحياناً إلى وجهين لعملة واحدة.
الحروب كأداة لإعادة الهيمنة
يرى تشومسكي أن الاستجابة الأمريكية لهجمات 11 سبتمبر تركزت في شعار "الحرب على الإرهاب"، وهو الشعار الذي تحوّل بسرعة إلى إطار شامل يبرر التدخلات العسكرية ويعيد إنتاج السياسات التوسعية للولايات المتحدة. بدلاً من الانفتاح على قراءة أعمق للأسباب التي تدفع جماعات عنيفة إلى استهداف المصالح الأمريكية، لجأت واشنطن إلى الحل العسكري المباشر، ما عكس طبيعة التفكير الإمبراطوري الذي يرى في القوة الوسيلة الأولى والأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات.
ينبّه تشومسكي إلى أن هذا الخيار العسكري لم يكن استثناءً طارئاً، بل امتداداً لمسار طويل من السياسات الأمريكية في العالم الثالث. فالدعم المتواصل للأنظمة القمعية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتدخلات الاقتصادية التي فرضت تبعية على الدول النامية، كلها عوامل غذّت مشاعر الغضب والرفض تجاه واشنطن. ومع ذلك، لم يُنظر إليها باعتبارها "جذوراً" للعنف، بل جرى تجاهلها لصالح خطاب اختزل المشكلة في "شر إرهابي" خارجي منفصل عن التاريخ والسياسة.
من زاوية أخرى، يوضح تشومسكي أن اختيار الحل العسكري ساهم في تسريع عسكرة النظام الدولي. فالتدخل في أفغانستان، ثم في العراق لاحقاً، فتح الباب أمام سباق تسلح جديد وأعاد تبرير وجود القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف القارات. وبدلاً من أن يشكل النظام الدولي بعد الحرب الباردة فرصة لتعزيز الدبلوماسية والتعاون، جاءت "الحرب على الإرهاب" لتعيد أجواء الاستقطاب، حيث يُقسَّم العالم مجدداً إلى معسكر "معنا" ومعسكر "ضدنا"، وهي صيغة تذكر كثيراً بمنطق الحرب الباردة ولكن بعبارات محدثة.
وبهذا، يصبح "الحرب على الإرهاب" ليس مجرد رد فعل أمني أو عسكري، بل أداة لإعادة تثبيت الهيمنة الأمريكية في العالم. فواشنطن لم تكتفِ بملاحقة تنظيم القاعدة، بل استغلت اللحظة لفرض أجندة سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة، تجعلها اللاعب المركزي في كل الملفات الدولية. وهنا يكشف تشومسكي المفارقة الكبرى: بدلاً من القضاء على الإرهاب، أسهمت هذه السياسات في توسيع دوائر العنف وتوليد أعداء جدد، الأمر الذي جعل العالم يدخل في حلقة لا تنتهي من الحروب والتدخلات.
الأثر الدولي: من أفغانستان إلى العراق
يعتبر تشومسكي أن إحدى أهم نتائج هجمات 11 سبتمبر كانت إعادة رسم خريطة التدخلات العسكرية الأمريكية على مستوى العالم. فقد جاء غزو أفغانستان كخطوة أولى تحت ذريعة "ملاحقة القاعدة وتدمير معاقلها"، لكنه في الواقع كان بداية لتثبيت الوجود العسكري الأمريكي في منطقة استراتيجية غنية بالموارد ومتصلة بآسيا الوسطى. بهذا، تحولت أفغانستان إلى مختبر أولي لسياسات "الحرب الوقائية" التي ستصبح لاحقاً جزءاً من العقيدة الأمنية الأمريكية.
لكن الحدث الأبرز الذي تبع ذلك كان غزو العراق عام 2003، والذي جسّد، بحسب تشومسكي، ذروة استغلال هجمات سبتمبر لتوسيع دائرة السيطرة الأمريكية. فبينما رُوّجت الحرب على أنها خطوة لحماية العالم من "أسلحة دمار شامل" لم يُثبت وجودها، فإن دوافعها الحقيقية ارتبطت بالتحكم في مصادر الطاقة وإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لواشنطن. هذا التدخل لم يكن مجرد حرب على دولة بعينها، بل تحول إلى رسالة للعالم مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام القوة المنفردة لتغيير الأنظمة السياسية.
يربط تشومسكي بين هذه الحروب وبين الانهيار التدريجي لمنظومة القانون الدولي. فالتدخل في أفغانستان والعراق تم بمعزل عن الإجماع الدولي، وغالباً في تحدٍ واضح لمؤسسات مثل مجلس الأمن. وبدلاً من تعزيز مبدأ الشرعية الدولية بعد الحرب الباردة، أدت هذه السياسات إلى تقويضه، ودفعت العديد من الدول إلى تبني سياسات أكثر عدوانية بدورها، ما ساهم في نشر الفوضى وزيادة الشكوك في مصداقية النظام العالمي.
المفارقة التي يبرزها تشومسكي هي أن ما سُمي بـ"الحرب على الإرهاب" لم يؤدِ إلى تقليص العنف، بل إلى تضاعفه. فالغزو الأمريكي وما تبعه من احتلال وصراعات طائفية أسهم في خلق بيئة خصبة لظهور جماعات أكثر تطرفاً، مثل القاعدة في العراق التي تحولت لاحقاً إلى تنظيم داعش. بذلك، أصبحت الحرب التي رفعت شعار مكافحة الإرهاب هي نفسها أحد أهم العوامل التي غذّت الإرهاب على نطاق عالمي، لتدخل البشرية في حلقة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار.
نقد الخطاب الأخلاقي
يعمل تشومسكي في هذا المحور على وضع الولايات المتحدة أمام مرآة تاريخها الفعلي، بعيداً عن الصورة المثالية التي تسوّقها عن نفسها. فحين تتحدث واشنطن عن "العدالة" و"الحرية" باعتبارهما قيمتين مطلقتين تقود من خلالهما العالم، يذكّر تشومسكي بممارساتها في فيتنام، حيث ارتكبت مجازر واسعة وقصفت المدنيين بلا تمييز، تحت ذرائع مواجهة الشيوعية ونشر الديمقراطية. هذا التناقض بين الشعار والممارسة هو ما يشكل لبّ نقده الأخلاقي.
كما يسلط الضوء على سياسات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، حيث دعمت الانقلابات العسكرية وأجهضت التجارب الديمقراطية التي لم تتفق مع مصالحها. فالمفهوم الأمريكي لـ"الحرية" بدا في كثير من الأحيان انتقائياً؛ يُسمح به حين يخدم النفوذ الأمريكي، ويُقمع إذا قاد إلى استقلالية وطنية أو توجه يساري. هنا يتجلى نفاق الخطاب، إذ تتحول الحرية إلى أداة هيمنة أكثر من كونها قيمة إنسانية عالمية.
ويضيف تشومسكي أن هذا التناقض لم يقتصر على السياسة الخارجية، بل انعكس في الوعي الغربي عموماً. فالغرب، بحسبه، يميل إلى النظر إلى نفسه باعتباره مركز الحضارة والإنسانية، بينما يتجاهل مسؤوليته عن إنتاج العنف العالمي عبر الاستعمار والحروب والتدخلات المستمرة. هذا الوعي "الانتقائي" يسمح للغرب أن يبرئ ذاته من الجرائم التاريخية، وفي الوقت ذاته يطالب الآخرين بالالتزام بالمعايير الأخلاقية التي يضعها هو.
بهذا النقد، لا يكتفي تشومسكي بكشف ازدواجية الخطاب الأمريكي، بل يفتح نقاشاً أوسع حول مفهوم "الأخلاق" في العلاقات الدولية. فحين تُستخدم القيم الإنسانية الكبرى كغطاء لتبرير العنف والتوسع، تفقد هذه القيم معناها الجوهري وتتحول إلى أدوات دعائية. من هنا، يطالب القارئ بإعادة التفكير في الخطاب الغربي ذاته، وإدراك أن مواجهة الإرهاب أو العنف لا يمكن أن تتحقق إلا بصدق الالتزام بالمبادئ الإنسانية، لا باستغلالها لخدمة الهيمنة.
قراءة نقدية للكتاب
تتمثل قوة كتاب "9-11" في جرأته الاستثنائية وسرعة صدوره في لحظة تاريخية كان يغلب عليها خطاب أحادي الجانب داخل الولايات المتحدة وخارجها. ففي وقت سيطرت فيه رواية رسمية تبرر الحرب وتدعو إلى الاصطفاف خلف القيادة الأمريكية، جاء صوت تشومسكي مختلفاً، ناقداً ومشككاً، ليمنح مساحة للتفكير النقدي الذي افتقده الكثيرون آنذاك. هذه المبادرة المبكرة جعلت الكتاب مرجعاً أولياً لفهم الأحداث من زاوية مغايرة للرؤية السائدة.
ومع ذلك، يواجه الكتاب بعض الإشكالات التي تحد من اكتماله كطرح فكري. أول هذه الإشكالات اعتماده الكبير على الخطاب التوثيقي والإحصائي، حيث يورد تشومسكي العديد من الأمثلة التاريخية والأرقام لإدانة السياسة الأمريكية، الأمر الذي يجعل بنيته أقرب إلى مقالات تحليلية متفرقة جُمعت في كتاب واحد، أكثر من كونها بناءً متماسكاً لمشروع نظري متكامل. هذا الطابع التقريري قد يُضعف من جاذبيته بالنسبة للقارئ غير المتخصص.
إضافة إلى ذلك، فإن التركيز المفرط على نقد الولايات المتحدة يجعل تشومسكي أحياناً يغفل أدوار الفاعلين الآخرين في إنتاج العنف العالمي. فالجماعات الجهادية العابرة للحدود، رغم كونها نتاجاً جزئياً للسياسات الغربية، لها أيضاً استقلالية فكرية وتنظيمية تساهم في تكريس العنف. إغفال هذه المسؤوليات يخلق انطباعاً بأن تشومسكي يفسر الإرهاب حصراً كنتيجة للسياسات الأمريكية، متجاهلاً الطبيعة المعقدة والمتشابكة لهذه الظاهرة.
وأخيراً، يظل الكتاب أسير دائرة "النقد" أكثر من "البناء". فهو يبرع في تفكيك الخطاب الرسمي وكشف تناقضاته، لكنه لا يقدم تصوراً واضحاً لمخرج عالمي بديل أو لرؤية متكاملة عن كيفية تجاوز دوامة العنف والحروب. هذا النقص لا يقلل من قيمة الكتاب كصرخة نقدية في لحظة تاريخية مضطربة، لكنه يحد من قدرته على أن يكون مشروعاً إصلاحياً أو خريطة طريق نحو نظام دولي أكثر عدلاً.
خاتمة
يبقى كتاب "9-11" محطة أساسية في أدبيات نقد الإمبراطورية الأمريكية بعد الهجمات. فهو يذكّر القارئ أن مأساة سبتمبر لا يمكن فصلها عن سياق أطول من التدخلات والحروب، وأن معالجة الإرهاب لا تنفصل عن إصلاح النظام الدولي ذاته. ورغم ما قد يُسجّل عليه من ثغرات، فإن مساهمته في فتح أفق للنقاش النقدي في لحظة سيطر فيها خطاب الحرب والخوف تظل ذات قيمة فكرية وسياسية بالغة.