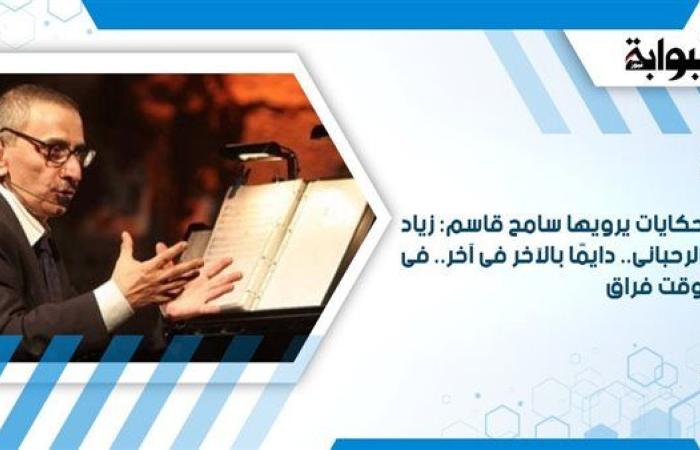فى كل عصر، ثمّة فنان يعيش بين الناس ويعيش فيهم، يتكلّم بلسانهم وإن لم يطلبوا، ويضحك حين يضيق الهواء، ويبكى حين يستيقظ العالم على خيبته المعتادة. هؤلاء لا يموتون كما يموت الآخرون، لأنهم، فى الحقيقة، لم يولدوا ولادةً عادية، بل انبثقوا من فورة أسى، من رعشة وتر، من أنين مقهى ليليّ، من حكاية لا تجرؤ على أن تُروى كاملة. وزياد الرحبانى كان واحدًا من هؤلاء.
حين أُعلن رحيل زياد، لم يكن ذلك خبرًا عاديًا فى شريط الأخبار. كان أقرب إلى انتفاضة هادئة فى ذاكرة مدينة. انطفأت شمعة كانت تُضيء الخسارة، لا لتُخفيها، بل لتُسميها، لتفضحها، لتغنّيها. لم يكن زياد مجرّد موسيقى أو كاتب أو مسرحى أو عازف، كان صيغةً متحوّلة من الوعى الحاد، الصوت الذى نعرفه حتى حين لا يتكلّم، الإيقاع الذى ينبض داخل وعينا الجماعى حتى وإن توقف النبض الفردي.

أن تموت فى عمر التاسعة والستين، هو أن تموت فى سنّ الذروة إذا كنت من أولئك الذين لم يهادنوا الحياة يومًا. أن تُطفئ آلاتك الموسيقية وتغادر، يعنى أن تترك خلفك أسئلة أكثر من الأجوبة، نكاتًا ناقصة تنتظر الضحك، مقاطع موسيقية تبدأ ولا تنتهي، وحزنًا لا شكل له. هذا ما فعله زياد اليوم. غادر، كما عاش، دون أن يُنهى عرضه الأخير.
منذ ولادته، كان مقدّرًا له أن يعيش فى الظلّ والنور معًا. هو ابن فيروز، ذلك الكيان الذى لا يُقارن، وابن عاصي، أحد مؤسسى الحلم اللبنانى المتخيّل، لكنه كان زياد، فقط زياد، منذ اللحظة الأولى. لا فيروز استطاعت أن تحتويه، ولا عاصى استطاع أن يوجّهه، ولا بيروت استطاعت أن تروضه، ولا جمهور الحبّ استطاع أن يفهمه تمامًا.
اختار أن يكون غريبًا داخل عائلته، ساخرًا داخل بلاده، حافيًا يمشى فى شوارع مملوءة بالشعارات. فى الوقت الذى كانت فيه البلاد تنقسم على نفسها وتتحول إلى خطوط تماس طائفية، كان هو يكتب عن الفقير والمهمّش، يُضحك ويُبكي، يُعرّى السلطة، ويغنّى للحب بصوت من يعرف أنّ الحب مجرّد مهزلة كبرى فى ظلّ الواقع.
كان زياد متورطًا حتى النخاع فى السياسة، لا بوصفها نشاطًا حزبيًا، بل كألم شخصيّ، كاحتجاج جماليّ على قبح العالم. لم يكن يساريًا فى الكتب، بل فى الشارع. لم يكن مثقفًا فى الأبراج العاجية، بل فى المقهى الشعبي، فى الحانة، فى عتمة المسرح، فى صمت الرصيف. وكان يسخر من الجميع: من اليمين لأنه غبي، ومن اليسار لأنه باع الحلم، ومن الناس لأنهم يريدون من ينقذهم دون أن يتحرّكوا.
وحين أحبّ، فعلها كما يليق بمن يعرف وجع الخسارات. كان الحب عنده مساحة للخيانة والتطهر معًا، وكان الفراق عنده لحظة موسيقية. لم يكن رومانسيًا، بل عاشقًا يكتب عن العدم، يتهكّم على العشق، ثمّ يعزف لحنًا يجعلك تحبّ رغم كل ما قاله.
نعم، كان صعبًا. عنيدًا. قاسيًا. متشائمًا حدّ الغضب. لكنه كان حيًّا. وهذا ما يميّز الكبار الحقيقيين: أنهم لا يعطونك ما تحبّ، وإنما ما تحتاج. وزياد لم يكن مريحًا لأحد. لا للطبقة السياسية، ولا للمثقفين، ولا للمتابعين الذين انتظروا منه أن يغنى فقط، بينما هو يفضّل أن يشتم، أن يفضح، أن يضحك بصوتٍ مجروح.
الآن وقد مات، يبدو أنه تركنا فى منتصف النغمة. تمامًا كما فعل فى مسرحياته: لا نهاية، لا جواب، لا خلاص. فقط علامة استفهام ترتجف عند آخر الجملة.
كيف نرثيه؟ لا بالكلمات وحدها. بل بأن نسمعه مجددًا. أن نستعيد صوته الغاضب، ضحكته الساخرة، يأسه الشريف. أن نعرف أنه حين غنّى "كيفك إنت؟"، لم يكن يخاطب حبيبته، بل يخاطبنا جميعًا.
منذ أن خرج زياد الرحبانى إلى العالم، كانت عيناه تشبهان عيون من رأى الحقيقة مبكرًا جدًا. عينان لا تشبهان عيون الأطفال، بل عيون الشيوخ الذين خبروا الخيبة فى سنّ الرضاعة. أن تكون ابن فيروز، أيقونة الصباحات اللبنانية، ووريث عاصى الرحباني، أمير الفصحى الموشّاة بالعود، لا يعنى أنك ولدت وفى فمك ملعقة من ذهب، بل ربما خنجر من ورق، تقضى عمرك كله تحاول إخراجه من حنجرتك دون أن تفقد صوتك.
كان زياد يعرف منذ طفولته أن لا مكان له فى "الحلم الرحباني". ذلك الحلم الذى يُرسَم على أعالى الجبال، وتغنيه الجوقات، وتلمعه الشمس على التلال. لكنّ زياد، منذ صغره، لم ينظر إلى الجبل لكنه نظر إلى الوادي. لم يؤمن بالضيع المثالية، بل آمن بالمدينة التى تختنق بالمجارى والسياسة.
لم يكن عاقًا لوالديه، بل لتراثهما. رفض أن يكون تابعًا، أو ظلًا، أو امتدادًا مريحًا لذاكرة الناس. رفض أن يُغنّى له كما يُغنّى للرموز. أراد أن يكون صوتًا لا رمزًا. أن يكون خطيئة جميلة فى تاريخ العائلة الطاهر، أن يكون النشاز الذى يجعل اللحن أكمل.
دخل المسرح فى وقت كانت فيه بيروت تتفكك: طوائف، جدران، متاريس، قتلة، بائعو شعارات، وصانعو أوهام. لم يكن عنده وقت ليرث "الأرز" و"الضيع" و"قمر المون"، بل كان عليه أن يتحدث عن الكهرباء المقطوعة، وعن عامل الهاتف الذى يكتب الشعر، وعن المرأة التى تحبّ رجلًا فقيرًا فى حيٍّ لا يتذكره أحد.
فى "سهرية"، قال كل شيء، وهو فى السابعة عشرة. كتبها كأنّه عمرٌ بأكمله. ثم جاءت مسرحياته تباعًا: "بالنسبة لبكرا شو؟"، "نزل السرور"، "فيلم أميركى طويل"، "شى فاشل"، "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". وكلها كانت، فى حقيقتها، هجاءً مضادًا لكل ما مثّله الأخوان رحبانى من جلال وأناقة وعالم مرتب.
فى مسرح زياد، لا مكان للبطولات المنمقة، بل للواقع كما هو: المقهى، الشاي، الورقة المقطوشة من الجريدة، صحن المجدّرة، رجل الأمن البليد، الحبيب الخائف، والنادل الذى يُفتى فى السياسة أكثر من النواب. كل هذا كان عالمه، لا عالم "راجعين يا هوى"، ولا "نحنا والقمر جيران".
لكن المفارقة أن زياد، فى تمرّده، لم يرفض الجمال، بل أعاد تعريفه. أخذ الجمال من علٍ، وأسكنه فى الشارع. جرّده من الترتيل، وأعطاه لهجة بيروتية وقحة، لكنها صادقة. جعل من الشتيمة فنًا، ومن الإيقاع الشعبى معزوفة للحقيقة.
لم يكن يخاف أن يكسر القالب، بل كان القالب نفسه يرتعد من اقترابه. لم يجامل اللغة، ولا النغم، ولا المتفرج. كان يكتب كما يتكلّم، ويتكلّم كما يفكّر، ويفكّر كما ينزف. وحين تعرّض للهجوم، من كل صوب، لم يتراجع، بل كتب أكثر، وقال أكثر، وضحك أكثر، كأنه بذلك يشير إلى فشلك فى إخراجه من روحه.
قال عنه كثيرون إنه الابن العاق، لكنه كان العاق الذى لا يترك البيت، لا يخرّب الحديقة، لكنه يكتب على الجدران: "لا أحد هنا بريء". كان ساكنا فى الحلم، لكنه كان يفتح النوافذ ليدخل الهواء الفاسد، لأن العالم الفعلى ليس مرجًا أخضر، بل كومة من الصراخ والأسرار.

وحين لحّن لفيروز فى مرحلة لاحقة، لم يعُد الابن المتمرّد فقط، بل غدا الكائن الذى استطاع، أخيرًا، أن يقنع السماء أن تنزل قليلًا، أن تخلع صندلها المقدس، وتدخل معه إلى بيت يعجّ بالمرايا المتشققة. لحّن لها "كيفك إنت؟"، فلم تعد الأمومة الغنائية صافية، بل مترددة، حزينة، متشققة من الداخل. ولعلّ هذا أجمل ما فعله: أن جعل فيروز، لحظة واحدة على الأقل، تشبهنا.
زياد لم يكن يُريد هدم التراث، بل تخليصه من التعليب. لم يكره الأب، بل كره التقديس. لم يهجر الأسطورة، بل نزف على أعتابها حتى تفهم أن الجمال ليس قمرًا على تلّة، بل شتيمة تقال فى وجه السلطة.
كان ابنًا عاقًا، نعم. لكنه كان العاق الذى لا نملك إلا أن نحبه. لأنه صادق. لأنه جريح. لأنه لم يكذب علينا مرة واحدة.
من بين يديه انسكبت بيروت كما لم تنسكب من قبل، لا كمدينة للسياحة، ولا كقمر على سفح الجبل، بل كألم موسيقيّ لا يُحتمل. لم تكن موسيقى زياد الرحبانى مجرد ألحان، بل كانت طريقة فى النظر إلى العالم. كانت كل قطعة موسيقية يكتبها، أشبه بمذكرة شخصية كتبها رجل وحيد فى ليل لا نهاية له، ثم وضعها على آلة البيانو، كأنّ الآلة صديق قديم لا يخونه.
منذ أن بدأ زياد العزف، لم يكن ينتمى لأى مدرسة موسيقية تقليدية. لم يكن طوع المعاهد ولا خاضعًا لقواعد الأكاديمية. موسيقاه خرجت من بيت فيه فيروز، ونمت فى شارع فيه الحرب، واكتملت فى أرصفة المقاهي، حيث يغنى الفقراء للحياة التى لا تُطاق. هو ابن التناقض بين قداسة الصوت الأمومي، وخطيئة المدينة التى تنزف.

يُقال إن الموسيقى انعكاس للعالم الداخلي، ولكن عند زياد، كانت انعكاسًا أيضًا للعالم الخارجي، ذاك المليء بالصفعات، بالعتمة، بالهزائم الصغيرة والكبيرة. لم تكن الموسيقى عنده زينة أو ترفًا، بل دفاعًا عن الكائن فى وجه السحق اليومي. ولهذا السبب، كانت ألحانه هجينة، عشوائية فى ظاهرها، لكنها تحت الجلد دقيقة كجراحٍ يشقّ الصمت.
فى مسرحياته الأولى، كانت الموسيقى تصرخ أكثر من النص. فى "نزل السرور" و"بالنسبة لبكرا شو؟"، لم تكن الأغانى مجرّد فواصل، بل تعليقات لاذعة على ما يجري، تواريخ موازية. الغناء لم يكن طربًا، كان توثيقًا لصراخ لم يُكتب فى الدساتير.
وحين دخل الجاز إلى بيروت على يديه، لم يكن استيرادًا أعمى من الغرب، كان كأنّه يكتشف صوته فى مرآة أميركية مكسورة. الجاز عند زياد لم يكن موضة، بل طريقة ليقول: "أنا لا أصدّق هذه الأنغام الشرقية المهذبة، أنا لست مطمئنًا إلى العود، أنا لا أرتاح للربابة، أريد شيئًا يشبه ارتباكي".
ولهذا، جاءت مقطوعاته مشغولة بالخروج، لا بالاستقرار. موسيقى لا تهدأ، لا تتكرّر، لا تُشبه إلا نفسها. فى ألبومه الشهير "مونودوز" مثلًا، لا يغنى الحب كما تعوّدنا، بل يغنيه كأنه نزفٌ عصبيّ، كأنّه صداع مستمرّ. الكلمة لا تأتى لتُهدّئ، ولكن لتُقلق. الجملة الموسيقية تُبنى على وعى محبط، لا على الحنين.
وفى أغانيه الشهيرة، تلك التى كتبها ولحّنها وغنّاها بنفسه، كان يعرّى الروح اللبنانية من زينتها الفارغة. فى "أنا مش كافر"، لا يدافع عن الإيمان، إنه يدافع عن الحق فى أن يكون الإنسان متعبًا، بلا أمل، بلا تفسير، بلا يقين. فى "شو هالأيام"، لا يغنى المرحلة، بل يُحاكمها.
وحتى حين كتب لفيروز، لم يُدخلها إلى عالمه فقط، وإنما جعلها تقول أشياء لم تكن تقولها من قبل. أغنية "كيفك إنت؟" التى لحّنها زياد، ليست أغنية حب، بل اعتراف خفيّ بالخسارة. نغمتها مثل جرّة ماء تتكسر فى منتصف الطريق. تَغنّى فيروز وكأنّها تعتذر، أو كأنّها تكتب رسالة وداع، لا بطاقة معايدة.
أعاد زياد تشكيل فيروز من صوت أسطوريّ إلى امرأة. جعلها أقل سحرًا، لكن أكثر صدقًا. وأكثر إنسانية. وأكثر وجعًا.
كان يؤمن أن الموسيقى الجيّدة لا تهدف إلى إسعادك، وإنما إلى أن تريك نفسك كما لم تفعل من قبل. ولهذا، لم يبحث زياد عن لحن جميل، بل عن لحن صادق. لم يسعَ إلى أن يُطرِب الجمهور، بل إلى أن يُشركه فى حيرته، فى عجزه، فى يقينه بأن لا يقين.
هو لم يُنشد للربيع، بل للشتاء القاسي. لم يُغنّ للحبيبة التى تنتظر على الشرفة، بل للحبيبة التى ذهبت ولن تعود. لم يُوزّع موسيقاه ليُرضى ذائقة السوق، بل ليُرضى قلقه، وخيبته الجمالية.
وبهذا، أصبحت موسيقاه سيرة ذاتية غير مكتوبة. كل نغمة هى جزء من مزاجه، كل إيقاع هو طريقة لقول: "أنا هنا، وهذا ما أشعر به، إن أعجبك أو لم يعجبك". موسيقاه لا تتوسّل إعجابك، ولكن تطلب منك أن تكون شريكًا فى الجُرح.
واليوم، وقد سكتت أنامله إلى الأبد، من يجرؤ على وضع يده على مفاتيح البيانو؟ من يستطيع أن يعيد تلك اللهجة الموسيقية التى تمزج بين بيروت ونيويورك، بين الجاز والتخت، بين الشتيمة والأمل؟ من سيكتب النوتة التى تصف ما لا يُوصف؟
مات زياد، لكن موسيقاه لا تموت. لأنها ليست موسيقى فحسب. بل ضمير. ورجفة. ومرآة لن نجرؤ على النظر إليها دون أن نكفّ عن الضحك.. ثم البكاء.