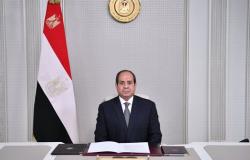العلاقة بين الثقافة والتطرف الفكري تمثل محورًا أساسيًا في النقاشات المعاصرة، حيث تُعد الثقافة الحاضنة الطبيعية للقيم الإنسانية والإبداع والتعايش، بينما يعكس التطرف حالة الفقر المعرفي والانغلاق. الثقافة ليست ترفًا أو نشاطًا نخبويًا، بل ضرورة حياتية تزوّد الأفراد بقدرة على الفهم والتأويل وتمنحهم بدائل عن الانخراط في دوائر العنف أو خطاب الكراهية، كما تشكل مصدرًا مهمًا لرأس المال الرمزي الذي يعزز وعي الجماعة الوطنية وقدرتها على مواجهة الأزمات.
غير أن الثقافة في كثير من المجتمعات العربية ما زالت تُعامل كخطاب منفصل عن الحياة اليومية، مما أتاح للتطرف أن يملأ الفراغ ويؤثر في العقول الشابة. من هنا يبرز السؤال المركزي: كيف يمكن تحويل الثقافة من خطاب نخبوي إلى صمام أمان مجتمعي ورافعة لإنتاج مفكرين قادرين على إعادة بناء الوعي الجمعي؟.. الإجابة تكمن في إعادة دمج الثقافة في الفضاء العام بوصفها ركيزة أساسية للتنمية ومواجهة الانغلاق.
الثقافة والتطرف
الثقافة مفهوم متعدد الأبعاد، فهي أنثروبولوجيًا منظومة العادات والقيم والرموز التي تشكل الحياة اليومية، واجتماعيًا نظام ينظم العلاقات والتواصل، وفلسفيًا تعبير عن قدرة الإنسان على الإبداع وإنتاج المعنى. بهذا المعنى، الثقافة ليست مجرد معرفة نظرية، بل أسلوب حياة يحدد رؤية المجتمع لذاته والعالم. ومن خلالها تتشكل الهوية الجماعية وتُبنى قيم الانتماء، حيث يمكن أن ترسخ التسامح والانفتاح أو على العكس التعصب والانغلاق، ما يجعلها معيارًا لصحة المجتمع وحيويته.
أما التطرف، فهو نتاج تداخل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ومعرفية؛ فالفقر والبطالة والتهميش يولدون شعورًا بالإحباط تستغله الجماعات المتطرفة لتقديم حلول وهمية، بينما يساهم الجهل والأمية الثقافية في إضعاف التفكير النقدي، ما يتيح للخطاب المغلق أن يسيطر. وإلى جانب ذلك، يقود القمع وغياب المشاركة السياسية إلى فقدان الثقة بالدولة والبحث عن بدائل متطرفة. هذه العوامل مجتمعة تهيئ بيئة خصبة لتوسع التطرف.
من هنا تتضح العلاقة الجدلية بين الثقافة والتطرف: كلما ضعفت الثقافة الحية والمنفتحة، تمدد التطرف ليملأ الفراغ. فالثقافة تمثل جهاز المناعة المجتمعي، إذ تمنح أدوات النقد والتحليل وتفتح المجال للتعددية، مانعة هيمنة الفكر الأحادي. لذلك يصبح الاستثمار في الثقافة ضرورة وجودية، ليس فقط لمواجهة التطرف، بل لتأسيس مجتمع قادر على الإبداع والتجدد.
الثقافة كأداة مضادة للتطرف
مواجهة التطرف تبدأ ببناء وعي نقدي يحرر الفرد من التبعية لأي خطاب مطلق، حيث تتحول الثقافة إلى تدريب عملي على السؤال والمراجعة والتمييز بين الرأي والحقيقة. التعليم القائم على النقاش الحر وتحليل النصوص يمنح الشباب أدوات عقلية تكشف تناقضات الخطاب المتشدد، فيما تساهم الأنشطة الثقافية والفنية كالقراءة والمسرح والموسيقى والرسم في تنمية الخيال ورؤية العالم من زوايا متعددة، ما يضعف التفكير الأحادي الذي يقوم عليه التطرف.
كما تفتح الثقافة مساحات مشتركة للحوار والتعبير، إذ تقدم السينما والمسرح والمنتديات الثقافية سرديات بديلة ومنصات للتواصل بين مواطنين من خلفيات مختلفة. هذه الفضاءات تقلل احتمالية الانزلاق نحو الصدام، بينما تسمح الفنون والآداب بتوجيه الغضب أو القلق إلى قوالب إبداعية وحضارية مثل الأغنية الاحتجاجية أو الفيلم النقدي، ما يجعل الثقافة بديلًا عمليًا عن العنف.
إلى جانب ذلك، تؤدي الثقافة دورًا في استدعاء النماذج المضيئة من التراث الإنساني والديني التي كرست قيم التسامح والعدل والاعتراف بالآخر، لتؤكد أن التطرف ليس امتدادًا طبيعيًا للدين أو الهوية، بل انحراف عنهما. الثقافة في جوهرها تراكم إنساني مشترك، والاعتراف به يضعف خطاب "نحن" مقابل "هم"، ويعزز الإيمان بأن الحضارة نتاج تفاعل مستمر، ما يجعلها أداة مضادة للتطرف وقاعدة للعيش المشترك.
المناخ الملائم للإبداع وإنتاج المفكرين
الإبداع يحتاج إلى مناخ من الحرية يحمي الأفكار من الرقابة والخوف، ويكفل الحقوق الفكرية للمبدعين، فيتحول إنتاج المعرفة من مغامرة فردية إلى مشروع مستدام. كما يتطلب موارد ومؤسسات مثل المكتبات، مراكز البحث، المسارح، والمعارض، إضافة إلى الفضاءات الرقمية التي توسع آفاق الباحثين. هذه البنية تجعل الطاقات الفردية جزءًا من حركة ثقافية جماعية مؤثرة.
غير أن المناخ الملائم للإبداع لا يتحقق بالجهود الفردية وحدها، بل عبر سياسات عامة تضع الثقافة في صلب مشروع التنمية. دعم الدولة للمؤسسات الثقافية وتمويلها يمثل استثمارًا طويل الأمد، لكن لا بد أيضًا من إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء مبادرات ثقافية مستقلة كالمراكز والمهرجانات والورش الشبابية، بما يضمن التنوع ويتيح ظهور أصوات جديدة.
أما الفضاء الرقمي فقد أحدث ثورة في الوصول إلى المعرفة، مانحًا فرصًا غير مسبوقة للتعلم والإبداع، لكنه في الوقت ذاته تحول إلى ساحة مفتوحة لخطاب التطرف. مواجهة ذلك تتطلب إنتاج ثقافة رقمية بديلة تقوم على التفكير النقدي وتشجيع المحتوى الإبداعي ودعم المنصات التعليمية والفنية، بما يحوّل الإنترنت إلى بيئة تعزز الإبداع وتدعم نشوء جيل جديد من المفكرين.
نحو جيل جديد من المفكرين
المفكر لا يولد في عزلة، بل هو نتاج بيئته الثقافية والاجتماعية. الموهبة وحدها لا تكفي، إذ تحتاج إلى تمكين وفرص عادلة تجعل الأفكار الفردية مشاريع فكرية مؤثرة. وحين تُتاح للطبقات المهمشة فرص المشاركة في الحياة الثقافية عبر التعليم الشامل والمكتبات العامة ودعم الفنون الشعبية، يمكن أن يبرز منها مفكرون يعبرون بصدق عن قضايا مجتمعاتهم، لتصبح الثقافة موردًا مشتركًا لا حكرًا على النخب.
الجيل الجديد من المفكرين يحتاج إلى تجاوز الفصل بين التخصصات، فالدمج بين العلوم الإنسانية والطبيعية يفتح أفقًا لإنتاج فكر معاصر قادر على التعامل مع تحديات العالم. كما أن الفنون – من مسرح ورواية وموسيقى وفنون بصرية – تشكل مصدر إلهام للفكر، إذ تحفز المخيلة وتطرح أسئلة وجودية وأخلاقية، ما يجعل الاستثمار فيها مساهمة مباشرة في تكوين مفكرين أكثر حساسية وعمقًا في قراءة الواقع.
تاريخ النهضة العربية ونماذج حديثة من دول مثل المغرب وتونس وماليزيا تؤكد أن المناخ الثقافي الحي يولد مفكرين جدد. حركة الترجمة والطباعة في القرن التاسع عشر أفرزت رموزًا مثل الطهطاوي والأفغاني وعبده، فيما أتاح الاستثمار في الثقافة والفنون في العصر الحديث ظهور أصوات شبابية وطاقات نقدية جديدة. هذا يبرهن أن المفكر انعكاس مباشر لحيوية المشهد الثقافي في بلده
التحديات والعقبات
أبرز العقبات أمام تحويل الثقافة إلى أداة فاعلة في مواجهة التطرف تتمثل في ضعف التمويل الثقافي وهيمنة الخطاب الأحادي. فالموازنات المخصصة للمؤسسات الثقافية تظل هامشية، مما يحد من قدرة المكتبات العامة والمسارح والمراكز البحثية على أداء أدوارها الحيوية، ويجعل النشاط الثقافي رهين المبادرات الفردية غير المنتظمة. في المقابل، يؤدي تقديم خطاب واحد باعتباره "الحقيقة المطلقة" إلى إقصاء التعددية الفكرية وتجفيف منابع النقاش الحر، ما يخلق ثقافة مغلقة تعزز الطاعة العمياء وتفتح الباب أمام التطرف.
إلى جانب ذلك، يسهم ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة في تكريس صورتها كترف نخبة لا كحاجة يومية، وهو ما يترك فراغًا تستغله خطابات الكراهية والتحريض. كما أن العولمة الثقافية، رغم ما توفره من تبادل للمعارف، قد تضعف الهويات المحلية وتولد شعورًا بالاغتراب أو رد فعل متشدد إذا غابت رؤية نقدية قادرة على التكييف. التحدي هنا هو بناء ثقافة قادرة على الانفتاح والتفاعل الخلّاق مع الآخر دون أن تفقد جذورها.
حلول عملية وتوصيات
إصلاح التعليم يمثل حجر الأساس لأي مشروع ثقافي مضاد للتطرف، إذ يتطلب الأمر إعادة هيكلة الفلسفة التربوية لتقوم على الإبداع والتفكير النقدي بدلًا من التلقين. تعليم الطفل كيف يسأل ويبحث ويناقش يمنحه حصانة معرفية ضد الخطابات المطلقة، فيما تتحول المدارس والجامعات إلى فضاءات لصقل المواهب وتجريب الأفكار. وإلى جانب التعليم، تبرز أهمية برامج القراءة والفنون التي تجعل الثقافة ممارسة يومية، مثل المكتبات المتنقلة والمهرجانات الشعبية والمسابقات الأدبية والفنية للشباب، بما يعزز الوعي الجمعي المنفتح والتعددية.
كما يلعب الإعلام الثقافي دورًا محوريًا في نشر قيم التسامح والانفتاح، من خلال قنوات وبرامج تثقيفية جذابة بلغة قريبة من الشباب. ويكمل ذلك تعزيز التعاون الدولي عبر التبادل الثقافي الذي يوسع الأفق ويكسر الانغلاق، إضافة إلى إنشاء حاضنات إبداعية ومراكز بحثية وورش ومسارح شبابية تمنح الأجيال الجديدة منصات للتعبير وإنتاج أفكار جديدة. هكذا تتحول الثقافة إلى أداة لبناء مجتمع متوازن، وتحمي الشباب من الوقوع في براثن العنف والكراهية.
الخاتمة
تشكل الثقافة أكثر من مجرد نشاط نخبوية، فهي استراتيجية دفاعية وتنموية تتيح تحصين الأفراد من التطرف، وصياغة هوية وطنية قادرة على التفاعل الخلّاق مع التحديات دون فقدان الخصوصية. لكن تحويلها إلى صمام أمان فعلي يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية تُدرِك أن النهضة لا تُبنى بالاقتصاد والسياسة فقط، بل ببناء عقل نقدي مبدع عبر التعليم والإعلام والمؤسسات المدنية، بما يفتح الطريق أمام أجيال جديدة تقدّم خطابًا بديلًا عن الكراهية وتؤسس لمجتمعات أكثر عدلًا وانفتاحًا وإنسانية.